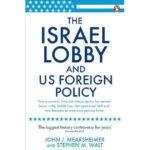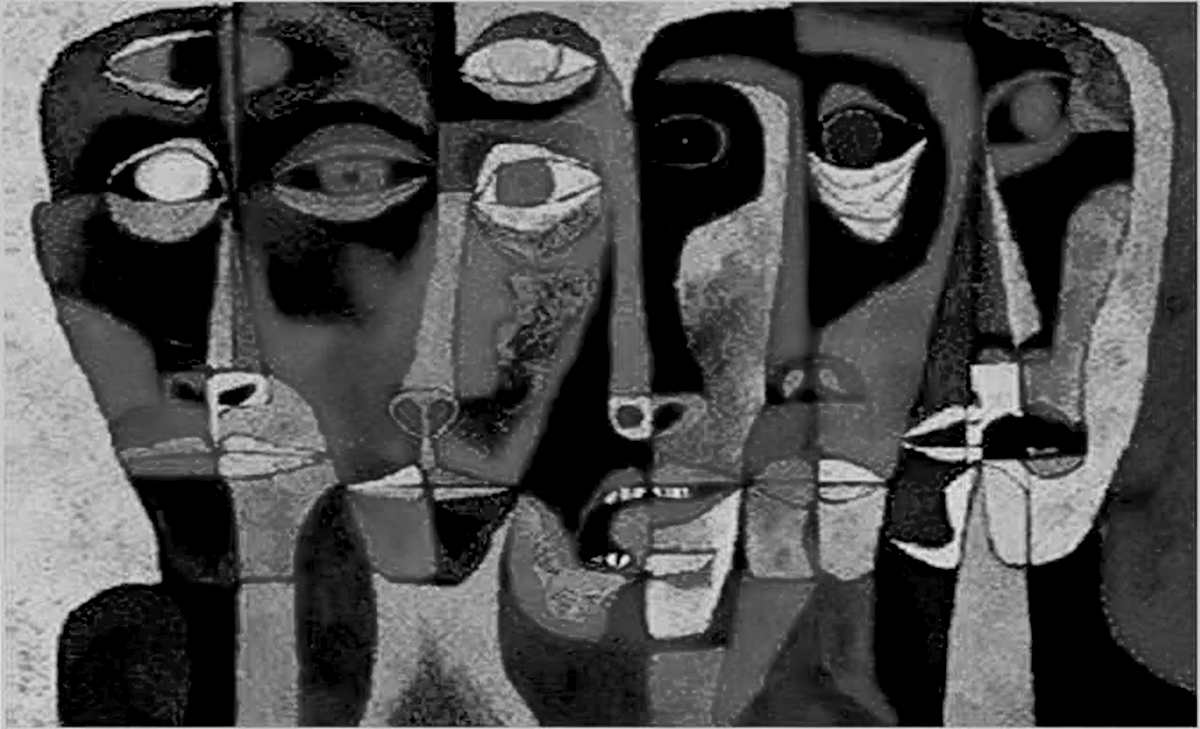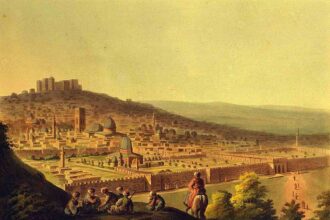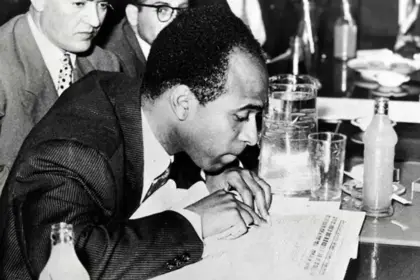(توطئة عن الترجمة :
قنما بحذف بعض الفقرات من ترجمتنا © لهذا المقال الهام والآسر- نشر بعنوان Resisting Neocolonial Genocidal Hyperreality: A Middle Eastern Voice- ، والفقرات التي قمنا بحذفها طلباً للإختصار متعلقة وفقاً للكاتبيين – Leila Faghfouri Azar و Shahin Nasiri الاستاذان في ” جامعة أمستردام ” – بما قام به النظام الإيراني منذ الملكيّة ثم لاحقاً الدولة الدينيّة من اضطهاد وقمع لليسار الوطني الإيراني، و إنّ حذفنا لهذه الفقرات لا يعني الموافقة او نفيها عن الموضوعات والأفكار، إنما أردنا أن نخفف من وطأة المحلية ونحافظ على السياق العالمي المشترك للمقال الهام، وندعو من يرغب بقراءة المقال كاملاً في المصدر المشار إليه في نهاية المقال)
نقد المقاربة النيو-كولونياليّة للإبادة الجماعيّة في فلسطين
في خضمّ المعمعة الفكريّة والسياسيّة المُحيطة بإبادة الشعب الفلسطيني، يسعى هذا المقال إلى إبراز وتوصيل صوتٍ مهمَّشٍ. إذ نهدف إلى التداخّل في ومع المناقشات الجارية داخل الأوساط الأكاديمية والجمهور الأوسع في الشمال العالمي، والتي غالبًا ما تُخفق في إدراك الواقع المعاش لشعوب الشرق الأوسط، الواقع الذي تشكّل، على مدى أكثر من نصف قرن، تحت وطأة قوتين متشابكتين: الحرب الاستعمارية الجديدة والاستبداد العرقي-الديني.
ونحن نطرح منظورًا شرق أوسطيًا مُميزًا، مُترسّخًا في تراث المقاومة الطويل ضد الإمبريالية الاستعمارية الغربية الجديدة وضد الاستبداد العِرقي-الديني. و نُعلِن من البداية، وانسجامًا مع الإرث الأخلاقي والسياسي لثوّارنا السابقين، تقديرنا المبدئي لتقاليد المقاومة التعدديّة (الأطراف والتوجهات الفكريّة) والجوهريّة عبر الشرق الأوسط وفي أنحاء أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.و إذ ان نكران التيارات الفكرية والسياسية التحررية الأخرى ليس مقصدنا، وكن نروم تعظيم صوتٍ مغيَّبٍ من اليسار الإيراني المستقلّ، الذي صمد وقاوم العنف الإبادي والقمع.
كما نحاجج، بعدم إمكان فهم الإبادة الجارية في فلسطين إلا إذا وُضعت ضمن تسلسل تاريخي أوسع للعنف النيو-إمبرايالي المستشري، والمقاومة الأصيلة في الشرق الأوسط خلال نصف القرن الماضي،و عبر هذا المنظور، نهيكل\نبني مناقشتنا حول ثلاثة دروس محورية : أولًا، أنّ التأطيرات المفاهيمية\الدلاليّة المهيمنة على العنف الإبادي – genocidal violence تُنتج وتُعيد إنتاج صور مثالية\نمطيّة للضحايا والمُنقذين. ثانيًا، أنّ هذه الأطر تحجب التداخل بين التدخلات النيو-كولونياليّة والأسباب الجذرية للحروب الإبادية في الشرق الأوسط. ثالثًا، أنّ الخطوة الحاسمة نحو هدم هذه الهياكل الهيمنية للعنف تكمن في إبراز أخلاقيات وسياسات حركات التحرر الحقة عبر الإقليم.
الضحية والمنقذ المثاليان
والدرس الأولي الرئيس الذي نستخلصه من موقف\منظور (نا الـ) شرق أوسطي هو أن التصورات الهيمنة لمعنى الإبادة – genocide تَستند في أساسها السياسي-المعرفي ” epistemo-politically ” إلى صور مثالية\نمطيّة للضحايا والمنقذين – saviours ، لقد تحمّل الشرق الأوسط عنفاً إبادياً وقمعاً متواصلين منذ عقود، من فلسطين ولبنان إلى إيران وأفغانستان والعراق وسورية واليمن، عايشت أجيالٌ طويلة معاناةً متواصلة والدماء المراقة بغزارة. ولا يزال، ذلك العنف والقهر المُدمِّرين يُستبعدان باستمرار من الخطاب السائد حول الإبادة. ولفهمُ مبررات هذا الاستبعاد يُقتضى في البداية تمحيص واستجواب المرتكزات المعرفية epistemological للتجسيدات التصورية المثالية ” idealised ” للضحايا والمنقذين، كما تُشكّل عبر أنظمة المعرفة القانونية-السياسية الاستعمارية.
فبحسب المفاهيم القانونية المهيمنة، تُعَدّ الإبادة مشكلةً إنسانيةً استثنائية ناتجة عن أفعال عنفٍ غير مألوفة تُرتكب ضد جماعات محمية، كما تُعرّفها اتفاقية الإبادة – Genocide Convention لعام 1948. وغالباً ما تُصنَّف الإبادة بأنها “جريمة الجرائم”، والتي تقع في ظروفٍ استثنائية وفي سياقات جغرافية وزمنيّة محدَّدة بدقة، ويستند هذا الإطار الاسثنائي الإنسانوي إلى علاقةٍ ثلاثية الأطراف هي من تؤسِّس له ، رابطةً بين “الجريمة الاستثنائية”، و”الجناة الأفراد”، و”الضحايا المثاليين” في\وللإبادة، ولكي يُعترف لشعبٍ مضطهد بكونه ضحية إبادة، يُطلب منه أن ينسجم مع روايةٍ لا تستقيم وتقتضي ألا يعاني فحسب، بل أن يكون عذابه وسهل القراءة ومقبولاً في أعين الغرب. إذ ينبغي أن يظهر جائعاً، مُحطَّماً، معتمداً على غيره، وبلا أيّة قدرة على النجاة، ولا بد من أن هذه المشهديّة – portrayal تقتضي وتشرِّع تدخُّلَ المنقذين الذين يُعيّنون أنفسهم بانفسهم. وهؤلاء المنقذون هم الدول الغربية، ومنظمات الإغاثة الإنسانية غير الحكومية، وإمبراطوريات الإعلام العالمية التي ستكون حاضرة لتُردّد لغة حقوق الإنسان.
وفي تحليلنا، فإنّ هذا التصور يبني ويؤصّل تأطيراً معرفياً وسياسياً مخصوصاً للـ”ضحية”، متأصّلٌ في المخيالات الإنسانيّة الاستعمارية وسياسات تشريع التدّخل وبالاستناد إلى مناهج الدراسات النقدية للإبادة، نحاجج بأن هذا التأطير يُشكِّل صورةً مثاليةً\نمطيّة للضحية. ومن الأهمية بمكان أن نستجوب نقدياً كيف تُروى هذه الرواية الإمبريالية، وأي أدوارٍ تُفرض بموجبها على الضحايا وعلى من يدّعون إنقاذهم.
وتحريّاً للدقة، فإن الضحايا المثاليين\النمطيين للعنف الإبادي يُصوَّرون كأنهم عاجزون وأبرياء، فهم، وهم إن كانوا معتمدين على إحسان المنقذين، فإنهم لا يُلامون على معاناتهم، وغالباً ما تُجسَّد هذه الشخصية ( للضحيّة) بصورٍ مألوفة ومؤثرة مثل الأطفال الجياع، والنساء الثكالى، والأجساد الممزّقة، أو الرجال والنساء الناطقين بالعربية الذين يحلفون بالله أنهم لم يرتكبوا جرماً.
إنهم يتضرعون إلى الضمير العالمي، وإلى الأمم المتحدة، وإلى منقذي حقوق الإنسان، وهذه هي بالتحديد صورة الشرق الأوسط التي تروّجها وسائل الإعلام الغربية بكثافة وتظهر متعلقة بها أشد التعلق.
يستند هذا التصوير\المشهديّة، في جوهره، إلى إطار ومنظور معرفي وسياسي وظيفي لطالما أُوْتِرَت به حناجر الإنسانيين المزهوين بأنفسهم، فالإنسان يُصبح بموجبه مرئياً فقط عبر معاناته، وصمته، وخضوعه. ويعمل هذا التأطير ضمن آليةٍ سياسية من شقيّن ؛
أولاً: يُصوَّر الضحايا البائسين كعاجزين عن المعرفة ومنطقها، وكساذجين سياسياً، يُفترَض أنهم غير مدركين لحالتهم، جاهلين بالأسباب الحقيقية لمعاناتهم. والأكثر اهميّة؛ هو انّهم منقطعون عن تاريخهم وديناميات السلطة. واستناداً إلى هذا المنظور، فإن الضحايا ليسوا مجرد جاهلين، بل هم في الأصل غير قادرين على التفكير السياسي أو الفعل، أو حتى على التعبير عن معاناتهم.
ومن ثم، يُنظر إليهم على أنهم عاجزون عن تخيّل أو التفكير في طرق بديلة للعيش أو في ترتيبٍ سياسي مختلف، أو في رؤية جديدة للأخلاق والعدالة. أضف إلى ذلك، يُجسَّد الضحايا العاجزون ببراءةٍ طفوليّة، يُصورون نقيّين وبريئيين لدرجةٍ يصعب معها أن يرتكبوا خطيئة أو جرماً. وكل انحراف عن مشهديّة البراءة هذه، سواء عبر التعبير السياسي أو التعبئة أو أي شكل من أشكال المقاومة، يحوّلهم إلى مشتبه بهم متوحشين.
والأهم، أن هذه الصورة\المشهديّة المثالية تمنع الاعتراف بالضحية بوصفها فاعلاً سياسياً. إنها تجردها من إمكانية كونها ذاتاً سياسية، ويفرض عليها هوية لا سياسيّة، يمكن اختزالها بسهولة إلى أرقام وإحصائيات ليقتبسها أبطال حقوق الإنسان، وهم الوجه الأخلاقي للغرب المتحضّر، إذ يعبرون عن حزنهم على الشاشات قاطبي الجبين.
ثانياً: يُصوَّر الضحايا البائسون بأنهم معتمدون عضويّاً على المساعدات الغربية، وتدخلاتها، ومصادقتها الأخلاقيّة. يُؤطَّرون وكأنهم محاصَرون بالموت والألم والجوع، حتى إن آفاق وجودهم كلها تبدو مقصورة على العَوز والمعاناة.
وضمن هذا التأطير، لا يكون الضحايا بحاجة وحسب، بل هم بطبعهم\جوهرهم دون الآخرين لأنهم غير قادرين على إعالة أنفسهم وإنقاذها. تُشيَّيء أجسادهم وعواطفهم وتجاربهم الحية وتُختزل إلى موضوعات\كائنات مفتقرة إلى نجدة منقذين ساميين ومتفوقين أخلاقياً وسياسياً واقتصادياً. وإضافةً إلى صناعة وتعزيز صورة الضحية الدونية، يخدم هذا التصوير غرضين سياسيين-اقتصاديين آخرين: يُشبع عقدة المنقذ الغربية، المتجذرة في الخطابات الدينية والعلمانية للاستعمار منذ القرن الرابع عشر، ويزوّد الصناعة الإنسانية الاستعمارية الجديدة – neocolonial النيو-كولونياليّة، التي تعتمد على إعادة إنتاج واستهلاك المعاناة والعجز والهشاشة في وجه التحديات – passive endurance.
ويتجلّى تلازم هذين العنصرين في طريقة تصوير(الهندسة المشهديّة) لضحايا المحرقة – Holocaust، التي تُعدّ في الخيال الجمعي للعالم الغربي النموذج الأول\الأصلي للإبادة، فهذا الاعتراف يقوم على إحساس بالعجز والبراءة حتى أنّ “حنة آرندت” استبطنته؛ إذ كتبت في مقالها “نحن اللاجئون – We Refugees” أن معظم اللاجئين اليهود الناجين من الإبادة، كانوا بخلاف الذين “يطلبون اللجوء بسبب فعل ارتُكب أو رأي سياسي تُبنّى”، إذ لم “يرتكبوا أفعالاً” و”لم يحلموا أبداً بأن يكون لهم أي رأي راديكالي”. وفعلاً، لكي يُعترف بإنسانٍ كضحية إبادة، ينبغي أن يكون خالياً من الفعل السياسي والرأي، وظلّاً معتمداً ينتظر التدخل والنجدة الرحيمة للمنقذين الساميين (من السمو – superior).
إن الواقع المعاش للفلسطينيين خلال العقود الماضية يقدّم شهادةً قوية على ذلك. فالدمار الإبادي الممتد لأرزاق الفلسطينيين وثقافتهم وبنيتهم البيئية ظلّ مستبعداً إلى حدٍ كبير من مجال الاعتراف القانوني، وتتجلى الإبادة البطيئة ضد الفلسطينيين في تقييد الوصول إلى المياه، وتدمير الزراعة والمؤسسات التعليمية، وإرهاب الدولة-المدعوم، والاغتيالات، والحبس الجماعي المنظم لملايين البشر في سجن غزة المفتوح، والمراقبة الشمولية. غير أن معاناتهم لا تصبح مرئيةً للاستجابة الإنسانية إلا حين تتماهى مع الاستعارات\الصور النوذجيّة – archetypical tropes وصور الضحيّة.
فهم، في نظر الإنسانوين، يستحقون التعاطف والحماية فقط حين يظهرون كأجسادٍ جوعى، عاجزة، منزوعة القوة، ومجرّدة من الإنسانيّة، وهنا يكشف منظورنا الشرق أوسطي زاوية للرؤية مختلفة جذرياً؛ ففي السياق شديد التسييس للصراعات في منطقتنا، تم تكريس صورة الضحيّة المثاليّة استراتيجياً من قِبَل القوى الغربية لخدمة غرضين متداخلين:
أولاً؛ لإخفاء الجذور الاستعمارية النيو-كولونياليّة للعنف الإبادي المُلحق بشعوبنا،
وثانياً؛ يتم فرض تلك الصورة لتجريد الحركات التحررية – التي هي مسعى وتوّجه أبطالنا الحقيقين – للشعوب الأصليّة من الشرعية وإضعافها، يستند هذا التسخير للصورة\المشهديّة إلى ثنائية سطحية بين ضحايا أبرياء تابعين\خاضعين من جهة، وبين “همج” غير متحضّرين، وإرهابيين، ومتعصبين لا-ساميين، وحوش يهدّدون شعوبهم والحضارة الغربية من جهة أخرى. واستناداً إلى هذه الثنائية، فإن الأفراد والجماعات الذين ينحرفون عن الصورة المثالية للضحية غير المسيّسة (مثلاً بالتعبير عن رأي سياسي أو بالانخراط في عملٍ سياسي) ينتهكون محددات البراءة والخضوع السلبي\غير المقاوم – passive subjugation ، وبالتالي يُعاد تشكيلهم\تمثيلهم كإرهابيين ومتطرفين، ثم يُؤطَّرون كتهديدٍ للضحايا المثاليين وللعالم المتحضّر.
وإذا لم يُحوَّلوا عن منهجهم، عبر المبادرات\المساعدات الإنسانية إلى اعتناق أديان الرأسمالية والنيو-كولونياليّة، أصبحوا أعداءً لا بد من هزيمتهم. ويُرسل تشكيل\رسم هذه الشخصية رسالةً واضحةً إلى من يتعرضون للعنف: مؤداها أن المقاومة، أو الفعل السياسي، أو تحدّي الخضوع السلبي التي يفها ويحددها خطاب\مشهديّة الضحية المثاليّة، هو شرٌّ محض. وهذه الثنائية الاختزالية تمحو حقيقة موقف ونضال الفاعلين السياسيين الذين يسعون إلى التحرر بينما يتحملون عنف الإبادة. والجهاز السياسي الذي يعضُدهذه الثنائية يعمد إلى اختزال أي مقاومة في الشرق الأوسط في الهمجية\الوحشيّة والإرهاب، لأن مثل هذه الحركات المقاومة التحرريّة تهدّد بكشف وتحدي التفوّق الأخلاقي والسياسي الذي يزعمه هذا الجهاز.
الدرس الثاني: الحلقة الواصلة بين الإبادة والنيو-كولونياليّة والاستبداد
إن الدرس الثاني الذي نستخلصه من منظور شرق أوسطي هو أنّ الجينيالوجيا الحقيقية للإبادة لا يمكن تفكيكها دون دراسة التشابك بين التدخلات النيو-كولونياليّة والأسباب الجذرية للعنف المستطير، وتُعدّ الحقائق والإحصاءات التاريخية المتعلقة بـ”تكاليف الحرب” مفضوحةً في هذا السياق. فمنذ التصديق على اتفاقية الإبادة لعام 1948 وغيرها من معاهدات حقوق الإنسان، تحوّل الشرق الأوسط إلى حيز مكاني لتدخلات عسكرية نيو-كولونياليّة متواصلة، تُوجّت في الحروب العدائيّة في فلسطين، وإيران، وأفغانستان، والعراق، وليبيا، وسوريا، واليمن.
ومن المفارقة أن هذه التدخلات العسكرية تم تبريرها باسم القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، تحت ستار الـ”حرب على الإرهاب”. وخلال العقود الماضية، ارتُكبت هذه الاعتداءات بشكل متعمّد من قِبَل الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وحلف الناتو، وإسرائيل، مُرسِّخةً حرب الإبادة كنمطٍ معياري. وتشكّل هذه الحروب العدوانية الجذرَ الحقيقي للإبادة الجماعية، والتدمير الثقافي، وانهيار البنى التحتية، والخراب البيئي، وتجويع شعوب الشرق الأوسط. إذ خلال حروب “الإرهاب” وعمليات الإنقاذ الإنسانية، تحوّل الشرق الأوسط إلى مختبرٍ لتجريب الأسلحة المدمرة، وتكنولوجيات المراقبة الشمولية، والاستراتيجيات العسكرية المُحطِّمة للإنسانية.
وقد جرّبت الديمقراطيات الغربية القنابل العنقودية، والقصف العشوائي للمناطق الحضرية، والذخائر اليورانيون المستنفذ (DU)، والفوسفور الأبيض، وقاذفات الخنادق العميقة، وقنبلة “MOAB” (أم القنابل)، وغيرها من أحدث أسلحة الدمار الشامل، مفلتة تماماً من أي عقاب. وفي هذه التجارب، تم تحويل ومعاملة ملايين البشر كحيوانات تجارب. وقد صوّروا كـ”أضرار ثانوية – collateral damage” لحروب هجينة، وضربات استباقية، وعمليات إنقاذ إنسانية.
ومنذ عام 2001، بشكل متواصل ، تم ذبح وتجريد أكثر من أربعة ملايين مدني، بينهم ملايين الأطفال، كأنهم نفايات بشرية،وما يزال ملايين آخرون يعانون من سرطاناتٍ لا شفاء منها، وعيوب خلقية، وإعاقات دائمة، وصدمات حادة، وعنفٍ مُطبّع في النفس، وإبادة ثقافية، واللااستقرار. كما أدت هذه الحروب “الإنسانية” إلى تهجير قسري لنحو خمسين مليون إنسان، مكوّنةً أكبر موجة تهجير جماعي منذ الحرب العالمية الثانية. وقد تُرك هؤلاء اللاجئون بلا مكان على قارعة الطريق عقوداً، مُحرومين من حقهم الأساسي في اللجوء، على يد من يزعمون أنهم أبطال حقوق الإنسان. وبسبب نظام الحدود الأوروبي ، أُلقي عشرات الآلاف من هؤلاء اللاجئين في مياه المتوسط، الذي بات أكبر مقبرة بحرية جماعية للاجئين في العالم.
وفقاً لـ ” أشيل مبمبي – Achille Mbembe “، تشخّص هذه الظواهر النكرو-سياسيّة (necropolitical) (نظريّة سياسيّة-اجتماعيّة تقوم على نقد وجود نظام يوظّف السياسي والاجتماعي لإملاء شروط ومحددات استحقاق الحياة أو نفيها) الطبيعة النيو-ليبراليّة للنظام العالمي الراهن. فهذا النظام لا يمثل هيكلاً قانونياً أو سياسياً فحسب، بل يشكّل حقيقةً ملتبسة للواقع(hyperreality) ( نفضّل هذه الترجمة على الترجمة المتداولة بالفرط واقعيّة) يجمع الخيالات الاستعمارية، والأساطير، والتسلسلات التاريخية، والتخوم المفاهيمية – conceptual demarcations، وضديات الصديق-العدو العرقية.
في الحقيقة الملتبسة للواقع هذه، يُقسّم العالم إلى بشرٍ فوق-بشريين، وبشرٍ دون-البشر، إلى “نحن” المزينين بالحق، و”الآخر” المشيطن، إلى مهد الديمقراطية والمستعمرات البربرية. في الحقيقة الملتبسة للواقع، لا تنطبق قوانين حقوق الإنسان الدولية ولا القانون الإنساني على دون-البشر، في الحقيقة الملتبسة للواقع، حياة دون-البشر لا تستحق الحداد؛ إنها تستحق فقط أن تُؤرشف كإحصائيات في تقارير الإعلام والجيوش. في الحقيقة الملتبسة للواقع ، يُنكر ويُخفى عذاب ملايين البشر في الأرض تحت نفاق مراسيم وطقوس إحياء ذكرى الإبادة ، وشعارات إنسانية مُفرِطة وفارغة، وقمم أمنية عالية المستوى. في هذه الحقيقة الملتبسة للواقع، أدوات حقوق الإنسان ليست مُعدّة لحماية البشر من العنف الإبادي، بل تُسخّر كأسلحة لتصفية الخلافات الجيوسياسية.
ولفهم طبيعة الإبادة والعنف الماحق، لا بدّ من الإقرار بأنّ النيو-كولونياليّة والديكتاتوريات الرجعية وجهان للحيقية الملتبسة ذاتها، وقد لعبت القوتان معاً دوراً أصيلاً في القهر البنيوي\المنهجي للحركات التحررية في الشرق الأوسط وسائر أرجاء العالم المستعمَر. فمنذ القرن التاسع عشر على الأقل، ظلّت هناك مُعاهَدة (غير) مكتوبة بين المستعمِرين والأنظمة الرجعية الاستبدادية.
وكما هو الحال في أميركا اللاتينية وأفريقيا، فإن معظم الأنظمة الاستبدادية الموالية للغرب في الشرق الأوسط جاءت إلى الحكم عبر انقلاباتٍ عسكرية نيو-كولونياليّة، وعن طريق قمع الحركات الوطنية المناهضة للاستعمار، وبالإرهاب الرسمي المموَّل من الدولة، والاغتيال الموجَّه لقادة الثورات. بل الأكثر من ذلك، ففي العقود الأربعة الماضية، عملت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كحليفين رئيسين للديكتاتوريات والأنظمة الإبادية في المنطقة. فالتكتلات الاقتصادية والعسكرية الاستراتيجية بين القوى الغربية العظمى، والمملكة الاستبدادية في السعودية، والحكم الشمولي في تركيا، ونظام الفصل العنصري في إسرائيل، هي تجلياتٌ لهذه المُعاهَدة المُلبسة لحقيقة الواقع.
وفي الوقت ذاته، نمت الحركات الرجعية والديكتاتوريات الدينية كـ(فِعْل) ردٍّ على القوة الاستعمارية الجديدة، على غرار قانون نيوتن الثالث في الحركة: لكل فعل ردّ فعلٌ مساوٍ له ومعاكس في الاتجاه. فصعود الجمهورية الإسلامية في إيران، وحركة طالبان والقاعدة في أفغانستان، وحماس في فلسطين، أو داعش في العراق وسوريا، هي حالاتٌ نموذجية تعبّر عن هذا الارتباط السببي. وجميع هذه الفاعلين الرجعيين يعملون وفق منطق الإبادة الشاملة والتدمير، ويؤدّون أدوارهم بوصفهم أشراراً مثاليين.
وبهذا تبقى ثالوثية “الشرير-الضحية-المنقذ” صامدةً ومُعَزَّزةً، فمن جهة، يُبرِّر وجود هذه القوى الشريرة تدخلات المستعمِرين الذين يقدّمون أنفسهم كمنقذي للإنسانية،ومن جهة أخرى، تبقى الضحايا المحايدون\الصامتون بانتظار منقذيهم الإنسانيين الذين يصلون إلى مسرح الجريمة دائماً بعد فوات الأوان،وعلى حدّ تعبير “ميشيل أغييه- Michel Agier” : تعمل التدخلات الإنسانية والعسكرية كذراعين لآلة تدميرية؛ الذراع الأولى تُحدث الأذى، والثانية تتظاهر بالعمل على شفائه.
الدرس الثالث: أخلاقيات وسياسات التحرّر
في ظل هذه المصفوفة السائدة للعنف، يبقى قائماً هذا التساؤل الحاسم: هل لا يزال مفهوم “الإبادة الجماعيّة” فاعلاً بصفته دالاً ذا معناً في سياق خطابٍ سياسي وقانوني تحرري؟
والجواب عندنا واضح: إذ لنزعزع – unsettle جوهر العنف المستعر ، لا بدّ أولاً من تحرير مفاهيمنا السياسية من إرثها القمعي ومحدداتها الاستبداديّة، فلكي ننشئ مجتمعاً غير عنيف، ينبغي أن نُحرّر (تصوراتنا لـ) حقوق الإنسان والحرية من التراتبيّة\الهرميّة المتجذّرة بين المستعمِر والمستعمَر، بين المنقذ والضحية، بين المحرَّر والمحرِّر.
(…)