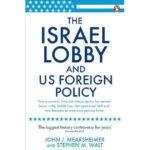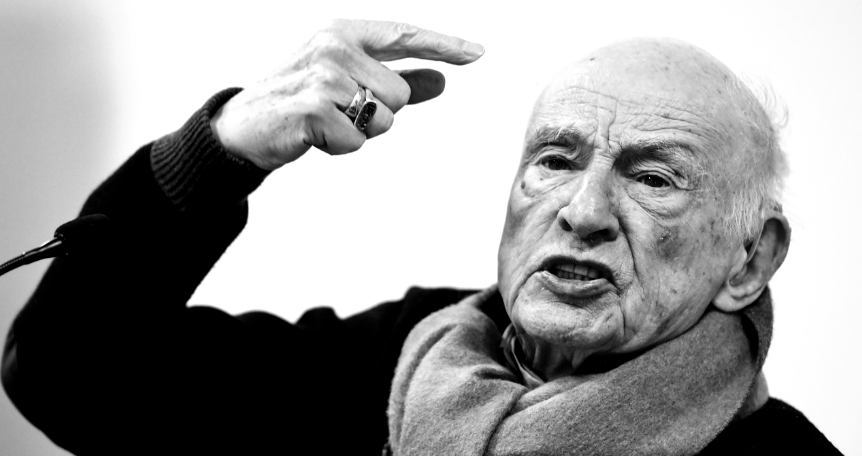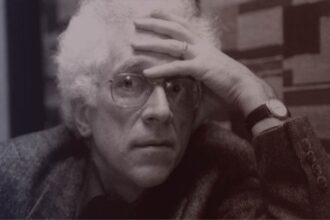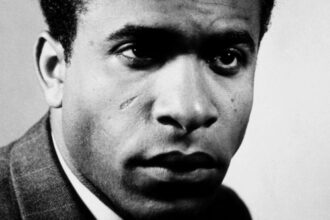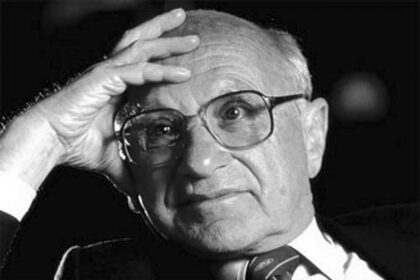مجلة ” علوم إنسانية ” : كما هو معلوم، أنتم تدافعون، منذ وقت طويل، عن تصور خاص للمعرفة وكذا العلاقة التي تربط الإنسان بالعلوم . كيف يمكن، في نظركم، توصيف المعرفة حاليا ؟
إدغار موران : تقتضي الإجابة عن سؤالكم، الرجوع شيئا ما إلى الوراء، خاصة عصر الأنوار . ذلك أنه، يمكن اعتبار أن مخزون المعرفة في أوربا منذ القرن الثامن عشر، قد بلغ حدا وإشباعا ما … فمن الصحيح القول – رغم ما عرفته العلوم من تطور، منذ بداية القرن السابع عشر، أي من مونتاين إلى باسكال، إلى ديدرو – بافتراض أنه ثمة هناك عقل مثقف، بإمكانه إدراك جوهر المعرفة عقليا لعصره والتفكير بالتالي, من علّ .
لقد خلق تكاثر المعرفة آنذاك , مشكلا . فمنذ المنتصف الثاني للقرن 18 , سجل تأسيس المشروع الموسوعي ل ” ألمبير ” و ديدرو منعطفا كبيرا، أي أنه بهذا العمل أخذ التكاثر المعرفي يتجه نحو تفعيله أبجديا لا منطقيا . وبذلك، تكدست المعارف وتراكمت شيئا فشيئا . للتذكير أيضا، إنه الشيء نفسه، بالنسبة لمعاجمنا وموسوعاتنا الحالية، التي ساهمت هي الأخرى , في تمديد عالم المعرفة، بشكل مهول,كما تساهم بشكل كبير من خلال تنظيمها الموسوعاتي . وعليه، أتاحت هذه الثورة الموسوعاتية تكاثرا للمعارف بفضل تشتتها وتوزيعها إلى وحدات بسيطة . الشيء الذي أتاح للمعرفة الإنسانية تموضعا جماعيا واسعا للغاية . غير أن هذه التجزئة , ستعرف تكاثرها من خلال عدد متزايد للتخصصات بشكل مستمر , مدافعة بالتالي , عن حدودها الدقيقة، إلى درجة، يصبح من الممنوع عليها التفكير في تلك الأواصر والتفاعلات التي بين مختلف دوائر المعرفة الإنسانية، كالذي لحقيقة المجتمعات أو ذلك للطبيعة .
لقد طورت كل أبحاثي – كما هو معلوم – في اتجاه معاكس للتجزئة وتقطيع المعرفة , مدافعا من أجل إمكانية إعادة تجميع المعرفة، وذلك في الربط بين العلوم الفيز رياضية، والعلوم الإنسانية، والعمل على إدماج الإنسان كموضوع للمعرفة وكعضو في نظام الطبيعة والكون .
ع – إ : كيف يمكننا إتاحة أشخاص ما، حيازة معرفة علمية هي دائمة السعة، ومنتثرة جدا باستمرار ؟
إ – م : إن المشكل الكبير في عالمنا الراهن هو ذلك لتنظيم المعرفة، ولنأخذ مثلا، المحيط الحيوي الذي يحتاج في الوقت ذاته إلى علوم الأرض، والعلوم الفيزيائية، والبيولوجية الخ . فلكي نفهم بشكل كبير، هذا المحيط الحيوي، طفا على السطح علم جديد، يدعى علم البيئة، هذا العلم أنتج بدوره مفهوم النظام البيئوي (Ecosystème) ؛ بمعنى، التنظيم العفوي بين الكائنات الحية ( الوحدة الحياتية / La biocénose), والشروط الطبيعية للوسط ( المدى الجغرافي / Le biotope ) .
هكذا، دون جمع ما يمكن جمعه من المعارف والإلمام بها جميعا، يقوم علم البيئة بهذا الدور، حيث يتمركز هذا الأخير حول معرفة منظِّمة، و هي معرفة كيفية تفاعل عناصر هذه المجموعة؛ بمعنى، كيف يتوازن النظام البيئوي، وكيف يختل؟ … ومع أن المعرفة بالنسبة للبيئيين لازالت غير دقيقة ( مثلا فيما يخص تسخين الكوكب ثانية ) فإنها تعرف تنظيما، وهذا ينطبق تماما بالنسبة لعلوم الأرض، علم الزلازل، علم البراكين، الجيولوجيا، علم الأرصاد، الخ …فإنها هي الأخرى، تنتظم وتتمفصل فيما بينها لدراسة الأرض كنظام معقد .
ع – إ : أن نمفصل المعارف فيما بينها، هذا ينحدر من آفاق مختلفة : هل يمكن أن يتم ذلك باعتبار هذا التنظيم التخصصاتي والمؤسساتي حاليا ؟
إ- م : إن تنظيم المعارف اليوم، يقع في تشاجر نظري، بين الانغلاق التخصصي وإعادة تنظيم التخصص المتعدد، ذلك أن التخصصات التي تم تأسيسها في القرن 19، جزأت المعرفة حسب حدود وهمية و اعتباطية لكنها مع ذلك صلبة . وعليه، بدأ يتجه، منذ الستينات، تجمع للتخصصات نحو تمامه؛ وبالتالي نحو حقائق معقدة . إنه حال علم الكون / الكوسمولوجيا، مثلا، في علوم الأرض، كما هو بالنسبة لعلم البيئة كما أشرت من قبل . لكن، كذلك بالنسبة لدراسة ما قبل التاريخ، يمكن لنفس الحقل العلمي أن يكون موضوعا لصدام بين تقسيمات واختزالات . وآية ذلك، البيولوجيا التي توزعت بين تيار اختزالي، وتمثله البيولوجيا الوراثية – التي تفسر الأشياء كلها من زاوية الجزيئات(molécules) والمورثات (gènes) – وذلك الذي للقطاعات الأخرى كعلم الأخلاق، وعلم الطفيليات، التي لا تريد أن تكتفي بذلك النمط الوحيد للفهم، الذي يتم من خلال لعبة الجزيئات . أما بخصوص العلوم الإنسانية، فنلاحظ تواصلا طفيفا بين الاقتصاد وعلم النفس وعلم الاجتماع .
بصفة عامة، سواء كان تموضعنا في(العلوم الاجتماعية، العلوم الإنسانية، البيولوجيا، علوم الطبيعة ) أو في العلوم الفيزرياضية، نلاحظ أن الآلية المؤسساتية تبقى بشكل أساسي، منظمة في تخصصات جامعة، إذ لا يوجد هناك ” كلية للكائن البشري ” فالإنسان البيولوجي يدرس بيولوجيّا، كما يدرس سيكولوجيّا, الإنسان النفسي … كما أن الإنسان الاجتماعي هو الآخر تجزّأ حسب أنشطته المعتقداتية والاقتصادية والسياسية والثقافية، حسب فضاءه أو تاريخه ,الخ .
إن المعارف التخصصية تتواصل فيما بينها بشكل ناقص للغاية، فكل واحدة منها تبقى معزولة في لغتها الخاصة، ومع ذلك، فتوجد هناك عقول لاتخصصية، تتطور من تخصص لآخر، غير أن هذه التجاوزات تبقى فردية وجد محدودة . لقد سبق أن قال هيبيرت كيرين بصفة عامة ,” إ ن العلميين كالذئاب، يتبولون ليرسموا حدودهم و ليعضوا بالتالي، الدخيل عنهم “.
ع – إ : إذا كانت هناك مؤسسة ما، تلعب دورا هاما في تكوين الثقافة، فإنها المدرسة طبعا . إنكم قد قدمتم تفكيرا حول المعارف للثانوية، ما هي افتراضاتكم من أجل إعادة إصلاح النظام التربوي على مستوى المعارف والد رايات ؟
إ – م : أعتقد أن هذا النظام ينبغي أن يتم وفق خمس مبادئ :
– الأول يقف وراءه مونتاين ” رأس مهيأة جدا خير من مليئة حشوا ” إذن، دماغ يعرف كيف ينظم المعارف، وهذا ممكن فيما أعتقد، وكما بينته في مؤلفاتي حول المنهج[1](1).
– الثاني , ذلك الذي ل ” رو سو” الذي قال في ” إميل ” : ” سأعلمه الشرط الإنساني ” إذن , العمل على جعل مختلف المعارف العلمية، والإنسانية والفنية، تتجه بشكل اتفاقي convergent لإضاءة الشرط الإنساني.
– المبدأ الثالث هو أيضا ل ” رو سو ” الذي قال فيه : ” ينبغي أن نعلمه كيف يحيا ” لقد كان شعر القرن 19 وروايته وكذا فنونه، مدرسة حقيقية للتعقيد الإنساني , في حين تسعى كل علوم هذا العصر إلى تهميش الفرد والذات وحذف كل ما هو ملموس.
– الرابع، يتعلق بتعلم المواطنة، لذا ينبغي لمن يدمج الآخر في علاقته، أن يمر عبر معرفة التاريخ، والفلسفة السياسية والعلوم القانونية . إن التاريخ – كمادة دراسية مقدرة أيما تقدير في فرنسا مع أنها في بلدان أخرى لا تحظى بنفس التقدير كما هو في الولايات المتحدة مثلا – ينبغي أن يعلمنا كيف نشعر أننا مواطنو بلدنا، وأوربا بل والأرض أيضا . إنه لمن الأصلح، أن يبني فتى ما، تمثلا ومعارف تهم التاريخ الوطني، لكن دون إهمال لتاريخ الإنسانية، حيث اكتشاف وجود هويات جماعية أخرى، وبالتالي وجهات نظر أخرى.
– – المبدأ الخامس، هو بلا شك، ذلك الذي ينقص تعليمنا، أي : تعلم مواجهة اللايقين . لقد بيّن لنا علم الكون، أن مغامرة ما للكوسموس لا يمكن أن يحاط بعلمها مسبقا، كما أن علم الأحياء الإحاثي((Paléo-biologie وكذا تاريخ الإمبراطوريات، يعلمنا أنه تمت هناك تدميرات ضخمة في الكائنات الحية . فالحتمية بالتالي انهارت، وأصبحت كل مغامرة للكوسموس و كذا المغامرة الإنسانية، ينبغي أن تتصور على أنها مواجهة مع اللايقين . إنه على هذا الذي ينبغي تهييئ العقول له، فلقد عرف نهاية هذا القرن اختفاء تصورين كبيرين للعالم، ذلك الذي للحضارات الكلاسيكية- كالأزتيك أو المصريين الذين كانوا يعتقدون بالزمن الدائري والاستئناف المستمر للعالم- وذلك الذي لمسيرة التقدم كقانون لا رجعة فيه , ولا مفر منه.
حاليا، لا يمكننا الحسم في القول إذا ما كان سيستمر التقدم، لأننا في مواجهة باللايقين، وهذا الذي ينبغي أن يكون غاية ومقصدا في التربية، عوض تهييئ أشخاص ينتظرون اللامنتظر واللامتوقع. لقد كانت هذه رسالة تكهنات أوريبيد منذ 2500 سنة !
ع – إ : لقد بدا لنا، أنه من الواضح جعل مختلف مراتب المعرفة، تتواصل فيما بينها، إلى جانب تعلم المواطنة الكونية، وتعليم اللايقين . لكن ما قيمة المعارف إذا لم تكن تسمح للإنسان أن يحدد فعله وقيمه ؟ كيف يمكن للإنسان أن يتصرف إذا كان لا يستند إلا لمعارف علمية , وحتى وإن كانت مركبة وتتقبل اللايقين ؟
إ – م : إنها فعلا قضية جوهرية، لأنه في وقتنا الراهن هناك قطيعة بين حكم فعل وحكم قيمة , بين الثقافة العلمية التي هي مجزأة بدورها، وتلك التي للثقافة الإنسانية التي يمكن أن تغذي الحياة والهويات والتصرفات . إن العلم ليس له إلا قيمة واحدة، ألا وهي البحث عن المعرفة من أجل المعرفة، حتى أصبحنا اليوم لا نعرف حدودها . لقد قرر النازيون أنه، بما أن المطلوب هو المعرفة، فالتجريب في البشرية إذن، ممكن وشرعي . كما بيّن، أيضا، استعمال الطاقة النووية والمناولات الوراثية، حدودا لايمكن أن يدركها إلا العقل الأخلاقي . وعليه , فالعلم لا يفرز أخلاقا، كما أتيح للحكماء الأقدمون الذين كانوا في الوقت ذاته، عارفين وأخلاقيين، وليس كما هو حال علمائنا اليوم.
ينبغي إذن، العمل على وصل الثقافتين معا، لأن انحلال إحداهما، يكون في غياب تلاحم بعضهما البعض . وفي تقديري , يمثل هذا حال الفلسفة اليوم، والتي منذ برغسون قطّعت أواصرها بالعلم، شاملا هذا التقطيع العلوم الإنسانية هي الأخرى، والنتيجة، عدم قدرة الثقافة العلمية في أن تفكر بصدد الثقافة الفلسفية و الإنسانية .
بالإضافة إلى ذلك , ينبغي بخصوص الإنسانيات أن تتجدد عبر الأدب , هذا الأخير الذي يفتقر إلى توظيف جدي يليق بمقامه، فالطلبة والتلاميذ عادة ما يتم إشباعهم بنظريات سيميوطيقية، وتراكيبية، وتحلينفسية ,الخ .. و هذا ما يجعلهم يفقدون شهية القراءة، في حين أن الأدب يعمل على إدراج الشرط الإنساني، في المعرفة وفي تعلم الحياة معا.
إن الإنسان الفاضل اليوم، لا ينبغي له أن يتغذى فقط بالعلوم، ولكن بالروايات والأشعار أيضا، فالنوعية الشعرية للوجود، ضرورية وأساسية، هذا بالإضافة إلى أن الأدب يدفعنا نحو التفكير في المصير الإنساني.
أجري هذا الحوار من طرف مارتين فورنيه ( Martine Fournier) و ج . ك .ريانو بوربالان – ترجمة : عمر بيشو