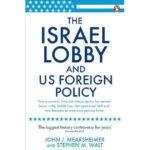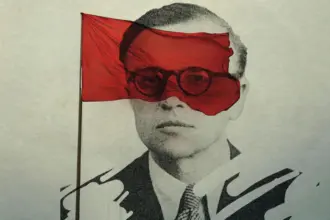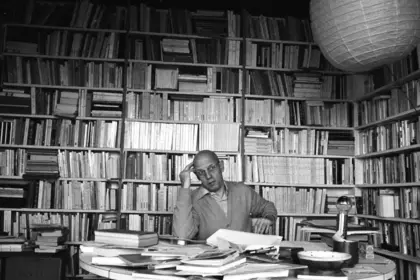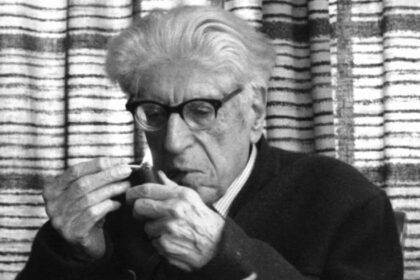توطئة :
(أطروحات في فلسفة التاريخ” أو ” حول مفهوم التاريخ ” (بالألمانية: Über den Begriff der Geschichte) هي مقالة كتبها الفيلسوف والناقد الألماني والتر بنيامين في أوائل عام 1940. تُعتبر واحدة من أشهر أعمال بنيامين وأكثرها إثارة للجدل. تتألف المقالة القصيرة من عشرين فقرة مرقمة، وقد كتبها بنيامين قبل محاولته الفرار من فرنسا فيشي، حيث كان مسؤولو الحكومة الفرنسية المتعاونة يسلمون اللاجئين اليهود مثل بنيامين إلى الجستابو النازي. تُعد الأطروحات آخر عمل رئيس أكمله بنيامين قبل هروبه إلى إسبانيا، حيث، خوفًا من القبض عليه من قبل النازيين، توفي منتحرًا في 26 سبتمبر 1940. وهذه الترجمة العربيّة الكاملة © لهذا النص.
ملاحظات : كل ما في النص من كلمات بين أقواس (…) في من إضافة الترجمة، اعتمدنا في الترجمة على مصدرين اثنين للتأملات، وفي حال وجود أية ملاحظة او اقتراحات يرجى مراسلتنا شاكرين)
والتر بنيامين : في مفهوم التاريخ (التأملات الكاملة)
I
تُروى قصة عن آلة صُممت بحيث يمكنها لعب الشطرنج رابحةً في كل مرة، إذ ترد على كل حركة للخصم بحركة مضادة. وهنالك دمية ترتدي زيّاً تركيّاً والنرجيلة في فمها جالسة أمام رقعة الشطرنج على طاولة كبيرة، كما شَكلت مجموعة مرآيا وهماً بأن الطاولة شفافة من جميع الجهات. بيد أن قزماً أحدب – الذي هو أستاذ في الشطرنج – كان يجلس داخل الآلة ويوجه يدها بالخيوط.
الآن بوسعنا أن نتخيل نظيراً فلسفياً لهذا الجهاز: إن الدمية المسماة “المادية التاريخية” من المفترض أن تنتصر دوماً؛ وذلك – وإذا ما استعانت بخدمات اللاهوت – الذي هو اليوم قد هرِم ويضطر للتواري والاستتار – فستكون خصماً لا يُقهر لأي شخص.
II
كتب ” لوتسه – Lotze ” : “من أبرز سمات الطبيعة البشرية، بجوار إيثار الذات و أنانيتها، غياب الحسد الذي يبديه كل حاضر تجاه المستقبل” إن هذا التأمل يكشف لنا أن تصورنا للسعادة مشّبع بالزمن الذي قُضِي علينا أن نحياه، فصورة السعادة التي تثير غبطتنا وُجدت فقط في الأجواء التي تنفسناها، بين أشخاص تحدثنا إليهم، ونسوة كنّ ليقدمن أنفسهن لنا. أي أن صورتنا للسعادة متشابكة أبداً مع صورة الخلاص (Erloesung). وينطبق الأمر ذاته على رؤيتنا للماضي، الذي هو موضوع التاريخ ذاته، إذ يحمل الماضي دليلاً زمنياً يحيل إلى الفداء\الخلاص.
ثمة ميثاقٌ خفي بين الأجيال السابقة والحالية: لقد كان قدومنا متوقعاً. وككل جيل سبقنا، أوكل إلينا نصيب قليل من قوة رسوليّة – Messianic نصيبٌ يُطالِب به الماضي. وهو حق لا يسدد بثمن بخس، والماديون التاريخيون يدركون ذلك.
III
الوقائع التي يسردها المؤرخ بلا تمييز بين عظيم الحوادث وبين أُخرٍ غير ذات شأن ينسجم مع حقيقة تقول: ما من حدث وقع يمكن اعتباره ضائع\مفقود على وفي التاريخ. بيد أن الماضي المكتمل لا يكتمل إلا لدى المُخلَّصيين؛ أي أن ماضيهم يصبح متاح الاستحضار بكل لحظاته، كل لحظة من الماضي تصبح اقتباساً\استشهاداً على جدول العمل – l’ordre du jour ، وذلك اليوم هو يوم الدينونّة.
IV
“اطلبوا الغذاء والكساء أولاً، ثم ستمنحون ملكوت الله”
هيجل، 1807
الصراع الطبقي، بصورته الحاضرة أبداً عند المؤرخ الماركسي، هو نضال من أجل الأشياء الخام والمادية التي بدونها لا تنوجد الأشياء الرفيعة والروحيّة، مع ذلك، فإن هذه الأمور الرفيعة لا تتجلى في شكل غنيمة محضة تؤول للمنتصر في الصراع الطبقي بل تتجلى صورها في هذا الصراع كشجاعة، وروح دعابة، ومكر، وجَلَد. وهذه القيم لها قوة تأثير رجعي وستظل باستمرار تُسائل كل انتصار، سواء أكان في الماضي أم في الحاضر، للحكام. وكما تميل الزهور نحو الشمس بقوة الانتحاء الشمسي- heliotropism ، يسعى الماضي، بدافع خفي، نحو تلك الشمس التي تشرق في سماء التاريخ. على المادي التاريخي إدراك هذا التحول المستتر.
V
الصورة الحقيقية للماضي تخفق مسرعة إذ لا يمكن اقتناص الماضي إلا كصورة تلتمع فجأة في لحظة إدراك لن تتكرر، هي لحظة وداعها الأخير.
تُشير عبارة ” غوتفريد كيلر- “Gottfried Keller : ” الحقيقة لن تَفِرَّ منَّا ” في منظور التاريخية (Historicism) إلى النقطة الدقيقة التي يَشُقُّ فيها النقد التاريخي المادي (Historical Materialism) طريقَهُ عبر التاريخية فأي صورة للماضي لا يعترف بها الحاضر باعتبارها من همومه المعني بها، ستتلاشى للأبد. (إذ تضيع بشرى المؤرخ الماضوي والتي حملها بقلب شَغِف في الفراغ في اللحظة ذاتها لنطقها).
VI
التعاطي التاريخي مع الماضي لا يعني “معرفته كما كان” (رانكه- Ranke)، بل تعني التمسك بذكرى (للهيمنة على الذاكرة) تومض في لحظة الخطر، إذ أنّ المادية التاريخية تسعى للاحتفاظ بصورة لماضٍ انبثق بشكل غير متوقع في مواجهة الإنسان\الذات التاريخية – historical subject الذي اختاره التاريخ في لحظة الخطر. يهدد الخطر * كلاً من محتوى ومخزون التقاليد ومتلقيها. ويحوم التهديد ذاته فوق كليهما: ألا وهو التحول إلى أداة في أيدي الطبقات الحاكمة. وفي كل عصر، يجب أن تتجدد المحاولة لانتزاع التقاليد من النزعة الامتثالية التي توشك أن تطغى عليها، فالمسيح لا يأتي فقط كمخلص، بل يأتي كقاهر للمسيح الدجال، و المؤرخ الذي فيه موهبة إذكاء شرارة الأمل في الماضي ، هو المقتنع أبداً بأن الأموات أنفسهم لن يكونوا في مأمن من العدو إذا انتصر، وهذا العدو لم يتوقف عن الانتصار.
* الخطر بحضوره كعلة للهيمنة والتبرير.
VII
” تأملوا الظلمة والبرد الشديد
في هذا الوادي الذي يدّوي فيه البؤس والغموض”
( بريشت- Brecht، أوبرا القروش الثلاثة )
يوصي” فوستل دو كولانج – Fustel de Coulanges ” المؤرخين الساعين إلى استعادة حقبة ما بأن يمحوا معرفتهم بمسلكها اللاحق، ولا توجد طريقة أفضل لتوصيف النهج الذي فشلت فيه المادية التاريخية من هذا. إنه إنغماس (في ذلك المنهج) منشؤه كسل القلب فقدان الشغف (الأسيَديا- acedia) الذي ييأس من فهم الصورة التاريخية الحقيقية والاحتفاظ بها وهي تخفق في إلتماعها السريع، لقد اعتبرها اللاهوتيون ( أي الأسيديا) في العصور الوسطى السبب الجذري للحزن.
وكتب فلوبير – Flaubert، الذي خبرها : “قلة من يدركون كم يلزم أن يكون المرء حزيناً ليحيي ذكرى قرطاج”.
تتجلى ماهيّة هذا الحزن حين نسأل: مع من يتعاطف أنصار التاريخانيّة فعلياً؟
الجواب الحتمي: مع المنتصر. فكل الحكام هم ورثة منتصري\فاتيحي الأمس، ومن ثم فإن التعاطف مع المنتصر يصب دوماً في صالح من يحكم.
وهذا ما يعرفه الماديون التاريخيون؛ فكل منتصر وفاتح لم يزل حتى اليوم يشارك في مواكب النصر ، الذي يدوس فيه من يحكم الآن على أولئك الذين يرقدون صرعى.
ووفقاً للعرف فسيجلبون (المنتصرون والفاتحون) معهم الغنائم التي تدعى “كنوزاً ثقافية”، أما المؤرخ المادي فيعاينها بتيقظ وتجرد، مدركاً أن منشأها غالباً ما يبعث الرعب؛ إنها تدين بوجودها ليس فقط لجهود العقول والمواهب العظيمة التي أبدعتها، بل أيضًا للعذابات المجهولة لمعاصريهم.
فما من وثيقة( إثبات ) تَحضُّر إلا وهي شهادة عن البربرية في ذاتها.
وتماماً كما أنّ هذه الوثيقة لا تخلو في ذاتها من بربرية، تظل البربريّة تلطّخ الممارسات التي تنتقل بها من سيد إلى سيد.
من هنا، ينأى المادي التاريخي عنها قدر ما يمكن، ويعتبر مهمته أن يقرأ التاريخ عكس السائد.
VIII
تعلّمنا تقاليد المقموعين أن “حالة الطوارئ” التي نحياها ليست استثناءً بل القاعدة. ويجب أن نصوغ فهماً للتاريخ ينطلق من هذه الحقيقة، عندها فقط سندرك بوضوح أن مهمتنا هي إحداث حالة طوارئ حقيقةً، ما سيحسن وضعنا في صراعنا ضد الفاشية.
إنّ أحد أسباب نجاح الفاشية هو أن خصومها يعاملونها وباسم التقدم كسنة من سنن التاريخ.
إنّ الدهشة الحالية بأن مثل هذه الأمور “لا تزال” ممكنة في القرن العشرين ليست فلسفية؛ فهي ليست مبدأ للمعرفة ؛ إلا إذا قادت (تلك المعرفة) لإدراك أنّ نظرةً كهذه للتاريخ واهية ولا تُبرر.
IX
” جناحي جاهز للطيران،
وأود لو أعود.
فلو بقيت وقتاً بلا زمن،
لكان نحسي اعظم.
Gerherd Scholem- “تحية من إنجيلوس”
تُظهر لوحة لكلي (klee) تُدعى ‘أنجيلوس نوفوس – Angelus Novus’ ملاكًا يبدو وكأنه على وشك الابتعاد عن شيء ينظر له بثبات، عيناه تحدقان، فاغر الفم، جناحيه مفرودين للتحليق. وهكذا يتصور المرء ملاك التاريخ ؛ وجه متجه نحو الماضي، إذ نرى نحن سلسلة من الأحداث، يرى هو فاجعة واحدة تُراكم الحطام والأنقاض لتُلقى امامه.
يودّ الملاك البقاء ليوقظ الأموات ويصلح ما تحطّم (يشير إلا فاوست لغوته)، لكن عصفاً يهب من الفردوس، وقد علق جناحا الملاك فلا يستطيع إغلاقهما، يدفعه العصف بلا حول منه ولا قوة إلى المستقبل الذي يُدير له ظهره، فيما تتضخم كومة الحطام أمامه؛ هذه الريح هي ما نسميه ” التقدم “.
X
كانت مواضيع\قواعد التأمل التي خصصها الانضباط الرهباني للرهبان مصممة لإشغالهم عن الدنيا وشؤونها. ومنهجيّة توليد الأفكار التي ننتبعها اليوم تنبع من اعتبارات مماثلة، ففي لحظة انكفأ فيها السياسيون الذين علّق عليهم معارضو الفاشية آمالهم، وأكدوا هزيمتهم بخيانة القضية فإن هذه الأفكار ترمي إلى تخليص المراهقين السياسيين من أحابيل الخونة.
مُنطلقنا؛ هو استيعاب أن ثقة السياسيين العمياء بالتقدم، واعتمادهم على “قاعدة جماهيرية”، وأخيرًا، إندماجهم الخانع في آلية لا يمكن السيطرة عليه، يعبر عن ثلاثة جوانب للشيء ذاته (أي ؛ الخيانة والتقهقر أمام الفاشيّة) .
والهدف من هذا أن نمثّل للثمن الباهظ الذي سيتعين على تفكيرنا المعتاد أن يدفعه مقابل تصور للتاريخ يتجنب أي تواطؤ\اتساق مع التفكير الذي لا يزال هؤلاء السياسيون يتمسكون به.
XI
إن النزعة الامتثالية التي كانت جزءًا لا يتجزأ من الديمقراطية الاجتماعية منذ البداية لا تتعلق بتكتيكاتها السياسية فحسب، بل بآرائها الاقتصادية أيضًا، وهذا أحد أسباب انهيارها لاحقًا.
لم يُفسد الطبقة العاملة الألمانية شيء بقدر فكرة أنها كانت تتقدم مع التيار، إذ اعتبرت التطورات التكنولوجية بمثابة تدفق من التيار الذي ظنت أنها تتقدم معه.
ومن تلك اللحظة، لم يكن الأمر سوى خطوة واحدة نحو الوهم بأن العمل المصنعي الذي كان من المفترض أن يتجه نحو التقدم التكنولوجي يشكل إنجازًا سياسيًا.
لقد بُعثت أخلاقيات العمل البروتستانتية القديمة بين العمال الألمان في شكل علماني. ويحمل برنامج “غوتا – Gotha” * بالفعل آثار هذا الارتباك، حيث يعرف العمل بأنه “مصدر كل الثروة وكل الثقافة” ، لقد اشتم ماركس رائحة الفساد، ورد بأن “…الرجل الذي لا يمتلك أي ملكية أخرى سوى قوة عمله ” يجب بالضرورة أن يصبح “عبدًا لرجال آخرين جعلوا أنفسهم المالكين…” رغم ذلك انتشر الارتباك، وسرعان ما أعلن “جوزيف ديتزغن – Josef Dietzgen ” : ” إن مخلِّص العصور الحديثة يسمى العمل، إن …تحسين… العمل يشكل الثروة التي أصبحت الآن قادرة على إنجاز ما لم يتمكن أي مُخلِّص من فعله أبداً ” يتجاوز هذا المفهوم الماركسي السفيه لطبيعة العمل مسألة كيفية تتمثل علاقة المنتجات والعاملين ، وهي لا تزال غير متاحة لهم!
إنه لا يعترف إلا بالتقدم في السيطرة على الطبيعة، وليس التراجع الاجتماعي؛ إنه يعرض بالفعل السمات التكنوقراطية التي ظهرت لاحقًا في الفاشية، ومن بين هذه السمات مفهوم للطبيعة يختلف – بشكل ينذر بالخطر – عن المفهوم الذي كان سائدًا في اليوتوبيا الاشتراكية قبل ثورة 1848.
إذ يتحقق المفهوم الجديد للعمل في استغلال الطبيعة، وهو يتعارض -ببداهةٍ – مع استغلال البروليتاريا، وبالمقارنة مع هذا المفهوم الوضعي، تُثبت خيالات ” فورييه – Fourier “، التي سُخر منها غالبًا ، أنها صائبة الحدس.
فوفقًا لفورييه، ونتيجة للعمل التعاوني الفعال، ستضيء أربعة أقمار الليل الأرضي، وسيتراجع الجليد عن القطبين، ولن يصبح ماء البحر مالحًا، وستطع الوحوش المفترسة أوامر الإنسان. كل هذا يوضح نوعًا من العمل الذي – بعيدًا عن استغلال الطبيعة – قادر على إخراج إبداعاتها الكامنة في رحمها،
فالطبيعة، التي كما يقول ديتزغن : ” موجودة مجانًا” هي مُكمّل للمفهوم الفاسد للعمل.
* وافق مؤتمر غوتا عام 1875 على اتحاد الحزبين العاملين، أحدهما بقيادة لاسال والثاني كارل ماركس وويليام ليبكنخت. صاغ البرنامج ليبكنخت ولاسال، وانتقده ماركس نقداً لاذعاً في لندن (راجع نقد برنامج غوتا).
XII
“نحتاج التاريخ، لكن لا كحاجة ذلك المدلل الكسول في حديقة المعرفة ”
” نيتشه، محاسن التاريخ ومساوئه”
ليس الإنسان أو البشريّة، بل الطبقة المكافحة والمضطهدة نفسها هي مستودع المعرفة التاريخية. فهي تظهر عند ماركس كآخر طبقة مُستعبَدة، وكمنتقم يُكمل مهمة التحرير باسم أجيال من المضطهدين.
لطالما كانت هذه القناعة، التي عادت إلى الظهور لفترة وجيزة في جماعة السبارتاكيون* (نسبة إلى سبارتكوس)، مرفوضة لدى الاشتراكيين الديمقراطيين.
ففي غضون ثلاثة عقود، تمكنوا تقريبًا من محو اسم “بلانكي – Blanqui ” في غضون ثلاثة عقود، على الرغم من أنه كان الصوت المجلجل الذي تردد صداه خلال القرن السابق. لقد رأت الاشتراكية الديمقراطية أنه من المناسب أن تسند إلى الطبقة العاملة دور مخلص الأجيال القادمة، وبهذه الطريقة قطعت أوتار أعظم قوتها.
فهذا الترويض جعل الطبقة العاملة تنسى كراهيتها وروح التضحية التي تتغذى من صورة الأجداد المُستَعبدين وليس من صورة الأحفاد المحررين.
* “السبارتاكيون” تيار يساري أسسه كارل ليبكنخت وروزا لوكسمبورغ لمعارضة سياسة الحرب، ثم اندمج بالحزب الشيوعي.
XIII
” كل يوم تزداد قضيتنا وضوحاً ويتعلم الناس أكثر.”
( فيلهلم ديتزغن – Wilhelm Dietzgen، “دين الديموقراطية الاجتماعية”)
لقد تشكلت النظرية الاشتراكية الديمقراطية، بل والأكثر من ذلك ممارستها، من خلال تصور ليس واقعياً للتقدم ، إذ بُني على ادعاءات عقائدية.
كان التقدم كما تم تصوره في أذهان الاشتراكيين الديمقراطيين، أولاً – وقبل كل شيء – تقدم البشرية نفسها (وليس فقط التقدم في قدرات البشر ومعارفهم). وثانيًا، كان التقدم مسألة لا متناهية متسقة مع فكرة قدرة البشري على الكمال اللامتناهي.
ثالثًا، كان يُنظر إلى التقدم على أنه شيء لا يُوقف، شيء يسير تلقائيًا\وذاتيّاً في مسار مستقيم أو حلزوني، وكل من هذه المسلمات مثيرة للجدل ومفتوحة للنقد، ورغم هذا، وفي التوقيت المناسب، يجب أن يتخطى النقد هذه المسلمات ويركز على المشترك بينها؛ فتصور التقدم التاريخي للبشرية لا يمكن فصله عن تصور تقدمها عبر زمن متجانس وخاوٍ، ولذا، فنقد هذا النوع من الفهم أساسي لنقد فكرة التقدم نفسها.
XIV
” الأصل هو الهدف.”
كارل كراوس- Karl Kraus، “كلمات في أبيات”، ج1
التاريخ موضوع بنية لا تسكن الزمن الفارغ المتجانس، بل الحاضر المشحون بـ”زمن الآن\الهاهنا” *. هكذا كان ” روبيسبير – “Robespierre يرى روما القديمة كماضٍ مشحون بلحظة الحاضر\الآن، مجتزئاً إياها من استمرارية التاريخ. لقد رأت الثورة الفرنسية نفسها روما المتجسّدة، تماماً كما تستحضر الموضة أزياء الماضي، فالموضة تميل فطريّاً للراهني\لإصطياد الحاضر مهما كان تعلقهما عظيماً بالغابر؛ إنها كقفزة نمر إنّما إلى الخلف \إلى ما مضى. غير أن هذه القفزة تحدث في ميدان تصدر فيه الطبقة المهيمنة الأوامر، أمّا القفزة الديالكتيكيّة التي رأى\فهم فيها ماركس الثورة إنمّا تحدث في الفضاء المفتوح للتاريخ.
* يشير بنجامين إلى “Jetztzeit” كمصطلح يتجاوز “الحاضر” ليعني الزمن الراهن المتكثف، أقرب للّحظة المثالية/الميتافيزيقية.
XV
إنّ وعي الطبقات الثورية أنها ستنسف الاستمرارية التاريخية هو ما يميّزها عند إقدامها على الفعل. ثمة تقويم جديد ابتدعته الثورة فاليوم الأول للتقويم ما هو في جوهره إلا آلة\كاميرا “تسريع زمني – time-lapse camera” (يرصد اللقطات بشكل متتالٍ وفي توقيت ثابت بين كل لقطة والتالية لها) هذا اليوم بعينه يتكرر بصورة الأعياد – أي أيام الذكرى، فالتقويمات لا تقيس الوقت\الزمن كما الساعات، بل تصبح نُصباً – monuments للوعي التاريخي – وعياً لم يظهر له أثر في أوروبا خلال القرن الماضي. ففي ثورة يوليو حدثت واقعة تشهد لهذا الوعي بالاستمرار: إذ في أول أمسيات المعركة، اتضح أن الساعات فوق الأبراج تتعرض لإطلاق النار في وقت واحد بعدة أماكن من باريس: كتب شاهد عيان وقد أوحى لها الإيقاع (أي إيقاع الطلقات):
من كان ليظن!
يَقُولُونَ : أنّ “يوشع” جديد
غَضْبَاناً مِنْ نهج الزَّمَنِ
واقفاً تَحْتَ كُلِّ بُرْجٍ،
وقد أطْلَقَ النار عَلَى قرص الساعة،
لِيوْقِفِ النَّهَارِ.
XVI
لا غنى للمؤرخ ، المادي – تاريخي \ historical materialist، عن فكرة الحاضر المتوقف\الثابت، فهو لا يرى الحاضر انتقالاً بل لحظة توقف\ثبات\خلود الزمن. لأنّ هذا المفهوم هو الحاضر الذي يكتب فيه المؤرخ تاريخه، التاريخانيّة – Historicism تورث “الصورة الأبدية” للماضي،إذ تمثل المادية التاريخية تجربة (من تجارب) وحيدة مع الماضي.
إنّه يترك الآخرين لتستنزفهم بائعة الهوى التي تدعى “كان يا ما كان” ( he whore called “Once upon a time” ) في ماخور التاريخانيّة، هو وحده يحتفظ بقواه، متيقناً أنه قادر على نقض استمرارية\تقدميّة التاريخ.
XVII
تنتهي التاريخانيّة بلا شك إلى تاريخ كوني شامل الذي هو مبلغها، وأبلغ ما يفترق فيه التأريخ المادي وهذه التاريخانيّة هو المنهج ، فالتاريخانيّة\الشاملة تخلو من بنية نظرية؛ طريقتها تراكمية؛ تسرد البيانات كما لو أنّها تملأ زماناً متجانساً فارغاً. أما المنهج المادي فأساسه ومنهجه في التأريخ فيتمثّل في البنية، فالفكر لا يقوم فقط على سيلان الأفكار بل على توقفها أيضاً\انقطاعها،حيث يتوقف الفكر فجأة في تراكيب مشحونة بالتوتر، قد تؤدي إلى “صدمة”، فتتبلور نتيجتها الأفكار في وحدة (موناد). والمؤرخ المادي لا يقارب موضوعه إلا حيث يصادفه كوحدة ، يرى فيها لحظة صفر\شلل- stillstellung رسوليّة – messianic للأحداث\القادم ، أو ، لنقل فرصة ثورية للنضال ضد استمرارية القهر لماضٍ مكبوت، وهو يدرك تلك اللحظة الرسوليّة ليقتلع حقبة تاريخيّة بعينها من سياق التاريخ المتجانس، كاشفاُ عن حياة بعينها في ذلك التجانس أو عملاً\حدثاً مؤثراُ – lifework بعينه في جملة\سيرة أحداث. والحصيلة الكلية لهذا تتمثل في أن يُحفظ الحدث – lifework في مجموعة الأحداث لتلك اللحظة ليذوب متلاشيّاً فيها- aufheben؛ والحقبة التاريخيّة تذوب متلاسيّةً في ذلك الحدث؛ و كذلك التاريخ الذي يذوب ليتلاشى في تلك الحقبة. والثمرة التي يعتاش منها لهذا الفهم التاريخي تحمل في باطنها الزمن كبذرة نفيسة، لكنها عديمة الطعم.
* يدل مصطلح هيجل “aufheben” على الحفظ والتحويل والإلغاء معاً.
XVIII
يكتب عالم أحياء معاصر : “بالمقارنة بتاريخ الحياة العضوية على الأرض” “فإن خمسين ألف عام من وجود الإنسان الحديث homo sapiens تمثل نحو الثانيتين الأخيرتين من زمن اليوم\الأربع وعشرين ساعةً. وقس على هذا أنّ مجمل التاريخ الحضاري للإنسان فهو يشغل خُمس الثانية الأخيرة من الساعة الأخيرة” أما اللحظة الراهنة\الآن وهنا، كنموذج للزمن الرسولي، الذي يختزل كامل التاريخ\الزمن البشري في تكثيف مهول، فهي تتطابق والمنزلة التي يشغلها التاريخ البشري في الكون.
تذييل :
أ. تكتفي التاريخانيّة بالربط السببي بين عناصر\حوادث التاريخ ، لكن أي حدث لا يصبح تاريخياً لمجرد كونه سبباً؛ بل يصير كذلك بعد انقضائه، بمجرد ارتباطه بمآلات تفصله عنها آلاف السنين. والمؤرخ الذي ينطلق من هذا الفهم يكف عن عدّ الوقائع كخرزات في مسبحة بين أصابعه، بل يتأمل النسق التي تشكله حقبته الحاضرة مع حقبة مضت بعينها. بذلك يرسخ فهماً للحاضر كزمن “الحاضر الآن وهنا- time of the now ” الموشّى ببقايا من الزمن الرسولي .
ب . لم يختبر العرّافون الزمن كزمن متجانس أو فارغ قط. من يعي هذا قد يدرك كيف عُمِل بالزمن الماضي في الذاكرة: بنفس السبيل. اليهود، مثلاً، مُنعوا من التحري عن المستقبل؛ لكن التوراة والصلوات وجهتهم إلى التذكر. بذلك زال السحر عن المستقبل الذي يسقط فيه من يستعينون بالعرّافين. ومع ذلك، فالمستقبل لديهم لم يتحول يوماً إلى زمن متجانس فارغ؛ إذ كل لحظة من الزمن هي بوابة ضيقة قد يدخل منها المسيح.
لا ريب أن زمن العرّافين، أولئك الذين استقرؤوا ما كان مستتراً في أحشاء المستقبل، لم يُعش قط بوصفه زماناً متجانساً أو فارغاً. ومن يدرك ذلك قد تتبدّى له فكرة عن كيفية اختبار الزمن الماضي بوصفه استذكاراً\استرجاعاً – remembrance؛ بل من المؤكد أنّ الأمر جرى على هذا النحو بعينه.
فمما هو معلوم أن الشريعة اليهودية كانت تحرّم على اليهود التطلّع إلى المستقبل. فقد وجّهتهم التوراة والصلوات إلى الاستذكار\الاسترجاع بدلاً من ذلك. وبذلك حُرر من الوهم disenchanted من كانوا قد وقعوا أسرى للمستقبل، وأولئك الذين التمسوا النصح من العرافين.
بيد أن المستقبل، رغم ذلك، لم يتحول عند اليهود إلى زمن متجانس وفارغ؛ إذ إن كل ثانية فيه مثّلت البوابة الضيقة التي قد يطل منها ، قادماً ، الماشيخ Messiah (بلفظ عبري).