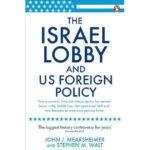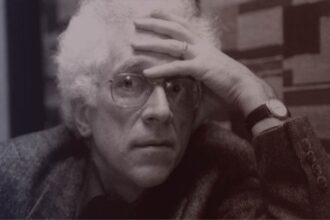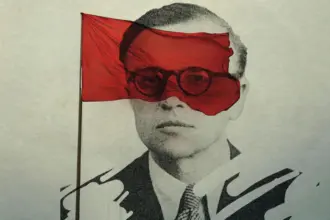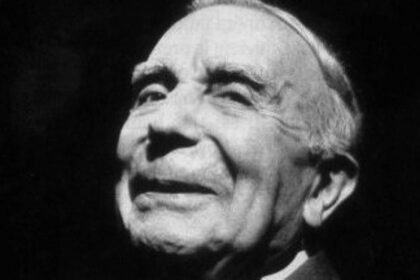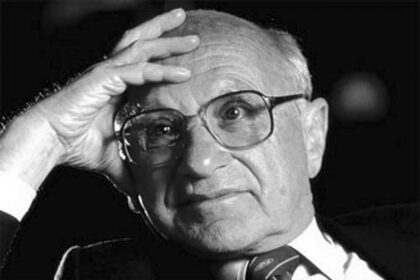نشر بعنوان : ” Hayek’s Bastards: The Populist Right’s Neoliberal Roots” للباحث والبرفسور” Quinn Slobodian ” أحد أبرز نقاد النيوليبرايّة، ويعد كتابه ” Hayek’s Bastards” من اهم الكتب في هذا الباب خصوصاً شرحه وتوسعه في باب اعلاقة بين النيوليبرالية والنظريات العنصريّة العرقيّة، وهذه ترجمة © من المقال المنشور.
ما النيوليبراليّة ؟
غالباً ما تُفهَم النيوليبراليّة على أنها مجموعة حلول جاهزة، بمثابة قائمة مهام لتفكيك النسيج الاجتماعي و دولة الرفاه. وتصفها ” نعومي كلاين – Naomi Klein ” بأنها ” عقيدة الصدمة- shock doctrine “: الانقضاض في أوقات الكوارث، والانهمام ببيع الخدمات العامة، ونقل السيطرة من الدولة إلى الشركات.
ويمثّل “إجماع\مجمع واشنطن” عام 1989 – المُعد أشهر أمثلة “الحلولية – solutionism” النيوليبراليّة – بوصغه ؛ “قائمة من عشر خطوات إجبارية على البلدان النامية، من إصلاح الضرائب إلى تحرير التجارة والخصخصة ” وفقاً لوصف الاقتصادي “جون وليامسون – John Williamson ” ، ومن هذه الزاوية، تبدو النيوليبراليّة كتاب طبخ\وصفات، ودواءً شافيّاً لكل الأمراض، وإكسير دجل لكل شيء.
لكن كتابات النيوليبراليين أنفسهم تقدّم صورة مغايرة – وهنا يجب أن نتوجّه لفهم ما يبدو كمتناقضات ظاهريّة في التجلّيات السياسية لليمين ، لنكتشف أن الفكر النيوليبرالي لا يفيض بالحلول بل بالإشكاليات.
فهل يمكن للقضاة أو الديكتاتوريين أو المصرفيين أو رجال الأعمال أن يكونوا حرّاساً أمينين للنظام الاقتصادي؟ وهل يمكن بناء المؤسسات وفقاً لمطيات مسبّقة أم لابد أن تنمو وتتطور ضمن نسقها الخاص؟ كيف يمكن أن تقبل الجماهير الأسواق رغم وحشيتها المتكررة؟
المشكلة التي شغلت النيوليبراليين طوال سبعين عاماً هي في التوازن بين الرأسمالية والديمقراطية. إذ كّن الاقتراع العام يعني حركات جماهيرية جريئة، تهدّد دائماً بإخراج اقتصاد السوق عن مساره المخطط له، عندما يستخدم الناخبون أصواتهم لابتزاز – من وجهة نظر النيوليبراليين – الساسة لمزيد من المنافع، ما يفرغ موازنة الدولة. لق خشي عديد منهم أن الديمقراطية قد يكون لديها ميل متأصل إلى الاشتراكية.
ولذا اختلفوا حول المؤسسات الكفيلة بحماية الرأسمالية من الديمقراطية: دافع بعضهم عن العودة إلى معيار الذهب – the gold standard، بينما رأى آخرون ضرورة تحرير العملات. وناضل قسم منهم نحو سياسات قويّة لمكافحة الاحتكار ، وقبل آخرون أشكالاً من الاحتكار. رأى فريقٌ أن الأفكار يجب أن تتداول بحرية، بينما أراد فريق آخر حقوق ملكية فكرية صارمة. اعتبر بعضهم الدين – religion شرطاً ضرورياً للمجتمع الليبرالي، وعدّه غيرهم قابلاً ليستغنى عنه.
رأى أغلبهم أنّ الأسرة التقليدية هي الوحدة الاقتصادية والاجتماعية الأساسية، لكنهم اختلفوا حتى في ذلك. بعضهم اعتبر النيوليبراليّة مسألة تصميم دستور صحيح، بينما رأى آخرون في الدستور – وباستعارة جنسيّة ملفتة – “حزام عفة – chastity belt مفتاحه دائماً في متناول من يرتديه”.
وإذا ما قورنت بغيرها من الحركات السياسية والفكرية، فإن غياب الانشقاقات المذهبيّة الفكريّة الجدية داخل الحركة النيوليبراليّة كان هو الملاحظ الأبرز، فمنذ الأربعينيات إلى الثمانينيات ظلّت “الوسطية” إلى حدٍّ بعيد صامدة.
وكان الانقسام الداخلي الوحيد ذا الشأن في أوائل الستينيات وهو انفصال الفيلسوف الاقتصادي الألماني ” فيلهلم روبكه – Wilhelm Röpke ” وهو واحدٌ من أبرز مفكري الحركة و”الأب الفكري” لاقتصاد السوق الاجتماعي. وقد بشّر هذا الانشقاق بصراعات لاحقة، إذ جاء تباينه مع غيره من النيوليبراليين في خضمّ تأييده الصريح لنظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، وتبنّيه نظريات العنصرية البيولوجية التي جعلت من الثقافة الغربية المشتركة والوراثة المشتركة شروطاً مسبقة لمجتمع رأسمالي فاعل.
ورغم أن الانخراط العلني في “البياض – whiteness” (كعقيدة عنصريّة) كان موقفاً غير مألوفٍ في ستينيات القرن العشرين، فقد عاد ليشقّ صفوف النيوليبراليين في العقود التالية.
وقد يرى البعض أن الجمع بين كراهية الأجانب ومعاداة الهجرة من جهة، والنيوليبراليّة – والمفترض أنها فلسفة الحدود المفتوحة – من جهة ثانية هو تناقض، لكن الواقع لم يَصدُق على هذه الفرضيّة في أولى ساحات التمدد النيوليبرالي ألا وهي ؛ بريطانيا تاتشر. إذ كتب “فريدريش هايك – Friedrich Hayek ” – الذي اكتسب الجنسية البريطانية بعد فراره من النمسا الفاشية – عام 1978، سلسلة من المقالات يؤيّد فيها دعوة تاتشر إلى “وضع حد للهجرة” قبل انتخابها رئيسة للوزراء.
وساعياً لإثبات وجهة نظره، استحضر هايك حال فيينا – مسقط رأسه – عام 1899، متذكّراً الصعوبات التي تسببت بها ” أعداد كبيرة من يهود غاليسيا وبولندا ” عندما قدموا من الشرق قبيل الحرب العالمية الأولى ولم يندمجوا بسهولة.
وكتب ” هايك ” من المحزن أن يكون واقعاً ” أن الإنسان المعاصر، مهما قبل مبدأً أن تُطبّق على الجميع القواعد ذاتها، فإنه لا يسلم بهذا المبدأ فعلياً إلا لمن يعدّهم شبيهين به، ثم يتعلّم وببطءٍ توسيع دائرة من يقبلهم على أنهم من أمثاله”.
ولم تكن مقترحات ” هايك ” الانغلاقية في السبعينيات انقلاباً صريحاً، لكنها مثّلت انعطافة عن النموذج السابق للمجتمع النيوليبرالي، الذي كان أكثر تأسيساً على فكرة عالمية إنسانيّة تحكمها دولة القانون في كل مكان.
وقد وجدت هذه النزعة التقييدية – restrictionist الجديدة صدى لدى الليبراليين البريطانيين الذين مالوا تقليدياً للتيار المحافظ (التورية – Tory) مقارنة بالميول الأميركية لليبرتارييين – libertarian\التحرريّة .
ومن مستجدات السبعينيات امتزاج خطاب هايك حول القيم المحافظة مع تأثيرات فلسفة جديدة هي ” البيولوجية الاجتماعية – sociobiology”، وكذلك امتزج ذلك الخطاب باهتماماته السابقة بالسيبرنيطيقا – cybernetics (علم التواصل والتحكم بالكائنات الحيّة) وعلم السلوك ونظرية الأنساق – system theory .
وقد أُطلق اسم “البيولوجية الاجتماعية” عام 1975 على كتاب لعالم الأحياء في جامعة هارفارد ” إدوارد ويلسون – E. O. Wilson ” الذي زعم أن سلوك الإنسان الفردي يمكن فهمه بمنطق التطوّر ذاته الذي يحكم الحيوانات والكائنات الأخرى، وأننا جميعاً نسعى إلى تعظيم تكاثر مادتنا الوراثية، وأن مصير السمات البشرية يمكن تفسيره عبر ضغوط\دوافع الانتقاء؛ التي تتخلص من السمات قليلة النفع وتعاظم\تنشر تلك السمات الأكثر نفعاً.
أعجب ” هايك ” بأفكار البيولوجيا الاجتماعية، لكنه شكك في مبالغتها في دور الجينات، مقترحاً أن التغير الإنساني يُفهم أفضل عبر ما سماه ” التطور الثقافي”. وفي حين كان المحافظون الأميركيون قد دشّنوا في الخمسينيات والستينيات “عقيدة ادماجيّة fusionism” بين ليبراليّة السوق والمحافظة – conservatism الثقافية (…) فإن انفتاح هايك على العلم أتاح في نهاية المطاف عقيدة ادماجيّة جديداً مكّن من الاستعارات المفاهيميّة المتباينة بين علم النفس التطوري، والأنثروبولوجيا الثقافية، وحتى علم العرق الذي تم احياؤه. وفي العقود التالية، امتزجت سلالات من النيوليبرالية neoliberalism مرارًا وتكرارًا مع سلالات من النيوليبرالية الجديدة.
ومع مطلع الثمانينيات، بدأ هايك يتحدث عن التقليد كمكوّن ضروري للمجتمع “الجيد\الصحي”. ففي 1982، أمام مؤسسة ” هيريتاج- Heritage Foundation” قال إن “إرثنا الأخلاقي” هو الأساس لمجتمعات السوق المعافاة، وكتب عام 1984: “يجب أن نعود إلى عالم لا يحكم فيه العقل وحده، بل العقل والأخلاق معاً، شريكين متساويين، حيث تكون حقيقة الأخلاق هي تقليد أخلاقي واحد، هو التقليد الغربي المسيحي، الذي صنع الأخلاق في الحضارة الحديثة”.
يقود هذا إلى استنتاج واضح؛ فبعض المجتمعات طوّرت على مدى قرون سمات ثقافية من مسؤولية شخصية وابتكار وعمل عقلاني و “تفضيل الوقت – low time preference ” ( تساهم هذه النظرية في حساب تفضيل الأفراد صرف الأموال في الوقت الحالي -كمثال- أو المستقبل ومن تطبيقاتها الكثيرة سعر الفائدة) بينما لم تتطور مجتمعات أخرى. ولأن هذه السمات لا تُستورَد أو تُزرَع بسهولة، فإن المجتمعات ” الأقل تطوراً ثقافياً ” – أي العالم النامي – ستكون بحاجة إلى فترة انتشار طويلة قبل اللحاق بالغرب، دون ضمان الوصول.
العرق والأمة
تدخّل التاريخ في 1989، وسقط جدار برلين،ومع هذا الحدث غير المتوقع، انفجر سؤال مدى إمكان زراعة ثقافة الرأسمالية أم ينبغي أن تنمو عضوياً. ونشأت “علوم الانتقال والإبدال – Transitionology” كحقل جديد لتحويل دول ما بعد الشيوعية إلى رأسمالية.
منح “جورج بوش” الأب “هايك” وسام الحرية الرئاسي عام 1991 بوصفه “رؤيوياً” صدقت أفكاره “أمام أعين العالم”، وربما افترض البعض أن النيوليبراليين سيمضون تسعينيات القرن العشرين في الاحتفال، يُلمّعون تماثيل الإقتصادي ” لودفينغ فون ميزس – Ludwig Heinrich Edler von Mises ” ( أحد أبرز و أقدم منظري الاقتصاد الحر والدفاع عنه ضد الاشتراكيّة) لعرضها في جامعات أوروبا الشرقية.
لكن الواقع كان عكس ذلك. تذكّر أن العدو الأوّل النيوليبراليين منذ الثلاثينيات لم يكن الاتحاد السوفييتي بل الديمقراطية الاجتماعية في الغرب، فمع سقوط الشيوعية، وجد العدو الحقيقي ساحات جديدة للتمدد. فقد أعلن “جيمس بوكانان” عام 1990 وهو آنذاك، رئيس جمعية “مون بليران – Mont Pelerin” : “الاشتراكية ماتت، لكن ليفياتان Leviathan (وحش أسطوري) ما زال حياً”.
لقد أثارت التسعينيات ثلاثة هواجس لدى النيوليبراليين: أولاً، هل من الممكن أن تتحوّل دول الكتلة الشيوعية الجديدة إلى لاعبين مسؤولين في السوق العالميّة بين عشية وضحاها، وما الضروري لذلك؟
ثانياً، هل الاندماج الأوروبي المتزايد يمهّد لقارة ليبرالية، أم أنه مجرد توسّع لدولة عظمى تعاظم فيها الرعاية الاجتماعية وحقوق العمل وإعادة التوزيع؟
وأخيراً، التحولات الديموغرافية: شيخوخة السكان البيض مقابل تزايد السكان غير البيض. فربما بعض الثقافات – أو حتى الأعراق – مؤهَّلة لإنجاح السوق وبعضها لا؟
افتُتحت التسعينيات بانشقاق داخل المعسكر النيوليبرالي بين من آمن بالمؤسسات فوق الوطنية مثل الاتحاد الأوروبي ومنظمة التجارة العالمية وقانون الاستثمار الدولي – ويمكن تسميتهم عالميين – وبين من رأى أن السيادة الوطنية – أو حتى وحدات انفصالية أصغر – هي الأجدى للنتائج الليبرالية. وقد زوّد هذا الانشقاق بعد سنوات، التحالف بين الشعبويين والليبراليين بالأسس الذي دفع بحملة الـ”بريكست” لخروج بريطانيا من الإتحاد الأوربي.
وإزاء تأثير ” هايك ” المتزايد لفكرة التطور الثقافي وتنامي شعبية علم الأعصاب وعلم النفس التطوري، اتجه كثيرون في معسكر الانفصال إلى العلوم ” الأقسى”،
فلم يعد كافيًا البحث عن أسس نظام السوق في المؤسسات أو السياسات؛ بل استلزم الأمر الخوض ” أعمق في اعماق الدماغ ” – على حدّ تعبير تشارلز موراي، عضو جمعية مون بليران، في مقالٍ له عام 2000.
وجلبت أزمات ما بعد 2008 التوترات بين المعسكرين إلى ذروتها. ومع قدوم أكثر من مليون لاجئ إلى أوروبا عام 2015، تبلور نظام سياسي ناجح وهجين جديد جمع كراهية الأجانب بقيم\مباديء السوق الحرة، لكن من المهم أن نرى بوضوح ما كان جديداً في اليمين وما كان موروثاً من الماضي القريب.
فحملة “بريكست” اليمينية، على سبيل المثال، قامت على أسس وضعتها تاتشر نفسها. ففي خطاب شهير في بروج عام 1988، أعلنت تاتشر أنّ “نا قد أعدنا بنجاح حدود الدولة في بريطانيا، لا لنعيد فرضها على مستوى أوروبي بدولة أوروبية عملاقة تسيطر من بروكسل”.
وملهماً بهذا الخطاب – والمرأة صاحبته والتي منحته وسام الفروسية – شكّل “اللورد رالف هاريس ” الرئيس السابق لجمعية “مون بليران” “مجموعة بروج ” في العام التالي.
واليوم، يزعم موقع المجموعة أنها “قادت المعركة الفكرية للفوز بالتصويت لترك الاتحاد الأوروبي”. فالـ”شعبويون” منحدرون من صفوف النيوليبرالبين.
وفي الوقت الذي يُعلي فيه أنصار “بريكست” شأن الأمة، فإن الاستحضار الصريح لـ”الطبيعة” يبرز بشكل أوضح في ألمانيا والنمسا. لعلّ المؤشر الأكبر في هذا الإدماجيّة- fusionism هو كيفية مزجها للقناعات النيوليبراليّة حول السوق بدعاوى مشككٍ بها من علم النفس الاجتماعي، والتركيز على الذكاء لافتٌ بوجه خاص: ففي حين جرت العادة على تلازم مصطلح “رأس المال المعرفي” مع منظري ماركسيين فرنسيين وإيطاليين، استخدمه الليبراليون مثل “تشارلز موراي” منذ عام 1994 في كتابه “المنحنى الجرسي – The Bell Curve” لوصف ما يراه فروقاً جماعية في الذكاء موروثة جزئياً ويمكن قياسها عبر معدل الذكاء (IQ).
أما السوسيولوجي الألماني ” إريش فييدي – Erich Weede” المؤسس المشارك لجمعية هايك (والحائز على ميدالية هايك عام 2012)، فليتحق تابعاً بالمنظّر العِرقي – race theorist “ريتشارد لين – Richard Lynn” فيرى الذكاء المحدّد الأول للنمو الاقتصادي. أما “تيلو سارازين – Thilo Sarrazin” العضو السابق في مجلس إدارة البنك الاتحادي الألماني، فيفسر ثراء الأمم وفقرها ليس بالتاريخ، بل بالصفات “العصيّة – intractable qualities” لسكانها. وقد باع كتابه “ألمانيا تمحو ذاتها- Germany Does Itself ” أكثر من 1.5 مليون نسخة في ألمانيا، ومهّد لنجاح أحزاب إسلاموفوبية مثل “البديل من أجل ألمانيا” (AfD)، مستشهداً بـ ” لين ” وباحثي ذكاء آخرين لرفض الهجرة من الدول ذات الأغلبية المسلمة بداعي انخفاض معدلات الذكاء.
تقدّم الادماجيّة- fusionism الجديدة بين النيوليبراليّة و”الطبيعية الجديدة – neo-naturalism” خطاباً لايؤسس لكونيّة إنسانية شاملة للسوق، بل رؤية مجزأة تستند إلى الثقافة والبيولوجيا. إذ لم ينحجز كل النيوليبرالين إلى مفاهيم ثقافية وعرقية استبعادية، بل ينظم بعضهم حملات ضد ما يرونه استيلاءً عدائياً على الإرث الكوني لـ”هايك” و “ميزس” من قبل كارهي الأجانب المتطرفين. غير أن حدة احتجاجهم قد تُخفي حقيقة أن “البرابرة الشعبويين” المزعومين قد تربّوا داخل الحصن عينه.
فالتركيبة الجديدة التي وجدت حلاً في العرق والثقافة والأمة هي أحدث سلالة\نسخة لفلسفة مؤيّدة للسوق لا تستند إلى فكرة أننا جميعاً سواء، بل إلى اعتبار أننا مختلفون بطريقة جوهرية، وربما دائمة. ومهما ضجّت الجدالات حول صعود يمين جديد، فإننا لم ندخل عصراً سياسياً ذا هندسة جذرية جديدة. و المبالغة في تصوير الانقطاع (في تلك الفلسفة والأيديولوجيا النبيوليبراليّة) تعني تفويت ( إدراك كنه) استمراريتها الجذريّة.