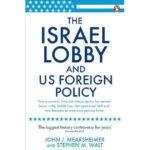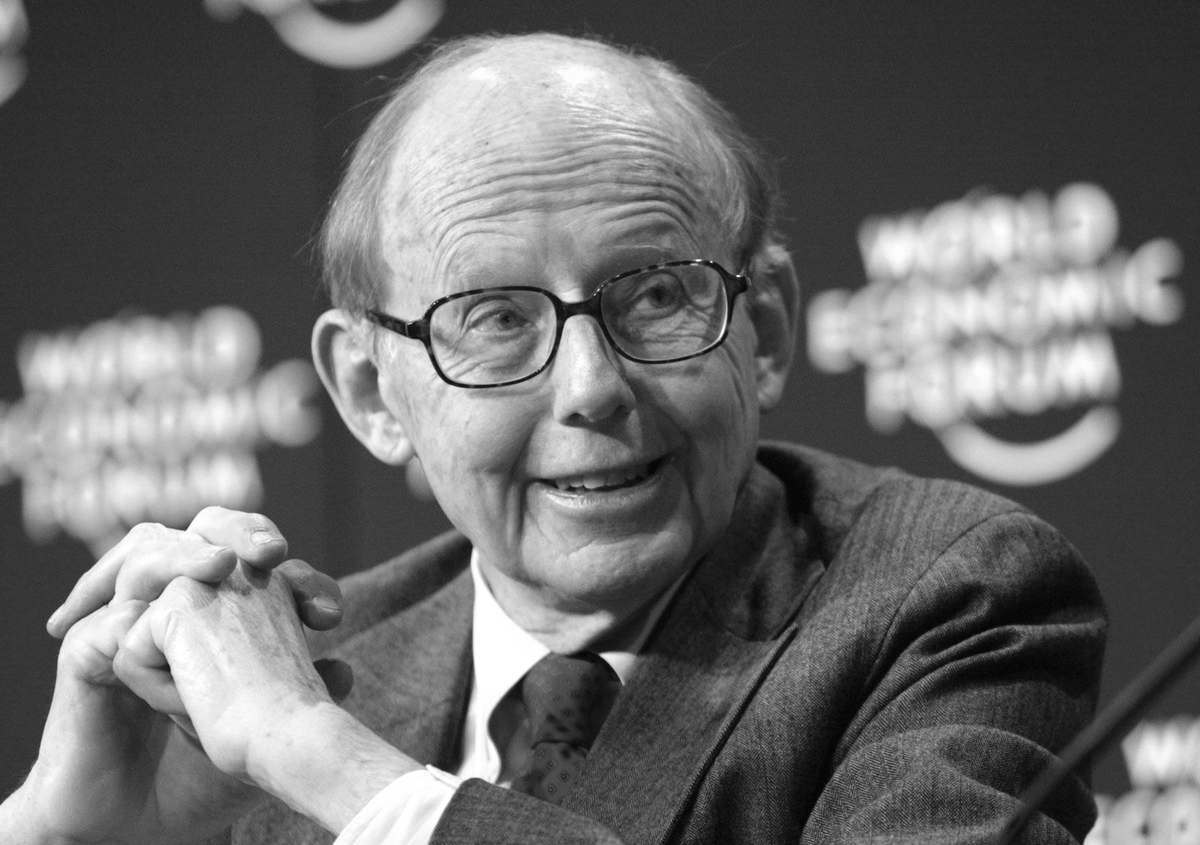( ظهر المقال بعنوان ” Samuel Huntington Is Finally Getting His Revenge on Francis Fukuyama ” وهذه الترجمة © الكاملة له)
صامويل هنتينجتون الذي ينتصر أخيراً من فوكاياما
نحن نقف على أعتاب لحظة إعادة ترتيب في العلاقات الدولية بأهمية تعادل تلك التي شهدتها أعوام 1989، 1945، أو 1919—حدث جيلي بامتياز، فكما كان الحال في تلك اللحظات التاريخية السابقة، فإن نهاية النظام الدولي الليبرالي الذي تبلور في التسعينيات هي لحظة مشحونة بالأمل والخوف على حد سواء، حيث تتلاشى اليقينيات القديمة، سواء كانت إيجابية أم سلبية. مثل هذه اللحظات المفصلية هي التي تبرز فيها الشخصيات الكاريزمية الجريئة على حساب المشغلين المتخصصين.
في كل نقطة تحول سابقة، كان النظام القديم يتجه نحو الإفلاس تدريجيًا، قبل أن ينهار فجأة، ورغم من أن الأمر لم يكن دائمًا واضحًا للمعاصرين، يمكننا أن نرى الآن- بأثر رجعي- أن النظام الجديد الذي كان سيبرز في كل حالة كان في أطوار التكوّن منذ فترة طويلة.
فعلى سبيل المثال، في عام 1919، كانت فكرة حظر الحرب وإنشاء برلمان للأمم مطروحة لعقود؛ وفي عام 1918، اقترح الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون ” حق الأمم في تقرير المصير ” كأساس لتأهيل الدول (على الرغم من أن ذلك كان يقتصر على الدول التي يتزعمها البيض).
وفي عام 1945، تم التخطيط لإصلاح عصبة الأمم مع مجلس أمن فعال قدر بدأ منذ عام 1942 ، رغم أن ظهور الأسلحة النووية في نهاية الحرب غير الحسابات، مما أدى إلى اندلاع الحرب الباردة. وقبل عام 1989، كانت فكرة نظام دولي “ليبرالي” أو “قائم على القواعد” كبديل للصراعات بين الشرق والغرب والشمال والجنوب قد طُرحت منذ السبعينيات.
كانت الهيمنة الجديدة بعد الحرب الباردة التي برزت في التسعينيات تقوم على عدة ركائز معيارية: (أ) ألا تُعاد كتابة الحدود الدولية بالقوة—وهو المبدأ الذي كان الدافع المعلن لحرب الخليج عام 1991 (ب) أن مبدأ السيادة الوطنية لا يزال ساريًا، ما لم تُرتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان؛ وهو استثناء تم تمثيله لاحقًا بشكل رسمي تحت مسمى “المسؤولية عن الحماية”. (ج) أن التكامل الاقتصادي والمالي العالمي يجب أن يُعتمد من الجميع لأن التجارة الحرة والعادلة ستفيد جميع الأطراف . و (د) أن النزاعات بين الأمم ستُحل من خلال مفاوضات قانونية في مؤسسات متعددة الأطراف حيث تمثل تحويل اتفاقية الجات (GATT) إلى منظمة التجارة العالمية (WTO) في عام 1995 التجلّي المؤسسي الرمزي لهذا المبدأ.
بالطبع، لم تخلُ هذه الركائز من التحديات؛ فالهيمنة ليست مرادفة للإجماع ، وعلى مدى الخمسة عشر عامًا الماضية، تم تحدي كل من هذه الركائز بشكل مباشر ومتزايد، خاصة من قبل روسيا “فلاديمير بوتين” وصين ” شي جين بينغ” وما وضع المسمار الأخير في نعش هذا النظام هو أن الولايات المتحدة، التي ادعت في التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين أنها الرائدة البطلة لهذه المبادئ، أصبحت الآن ترفض كل مبدا منها. و كما جادل ناثان غاردلز قبل بضعة أسابيع، أصبحت الولايات المتحدة – تحت قيادة دونالد ترامب المعاد تنصيبه – الآن القوة الرجعيّة الأولى في العالم، وهو ادعاء أكده مؤخرًا هوارد فرينش.
مع موت النظام القديم، يتمحور السؤال الرئيس الذي يسيطر على العلاقات الدولية اليوم حول طبيعة النظام الجديد الذي يكافح للولادة؛ فمهما كانت التسمية التي ستُطلق على هذا النظام الجديد في النهاية، فإن سماته المميزة تشمل علاقات التبادليّة-النفعيّة صفريّة المحصلة ( zero-sum transactionalism) في الاقتصاد الدولي، وسياسات القوة الثوسيديدية ( نسبة للمؤرخ الإغريقي ثوسيديدس) حيث “يفعل الأقوياء ما يستطيعون والضعفاء يعانون كما يجب عليهم\لدورهم أن يعانوا” والترسيخات القوية للسياسات الهوياتية المتمحورة حول “الدول الحضارية”.
ستتشكل هذه السمات في ساحة دولية أكثر اتساقاً\توازناً بكثير مما كانت عليه بعد سقوط جدار برلين، الذي وصفها تشارلز كراوثامر بـ”اللحظة الأحادية القطب” – حيث برزت الولايات المتحدة- وفقاً لتوصيف وزير الخارجية الفرنسي السابق هوبير فيدرين، كـ”قوة مفرطة الفرادة – Hyper Power”.
في تلك المرحلة الكبرى من إعادة التشكيل ، كان النقاش الأبرز في العلاقات الدولية يتمثل بين مقال “فرانسيس فوكوياما” “نهاية التاريخ (العنوان الكامل : The End of History and the Last Man) ” (الذي ظهر، متنبأً قبل شهور، بسقوط الجدار) و”صدام الحضارات ( النوان الكامل : Clash of Civilizations)” لـ “صموئيل ” هنتنجتون ” المنشور بعد أربع سنوات. وأقر فوكوياما نفسه بأن “نهاية التاريخ” لم تكن توصفاً لواقع تجريبي\استنباطي empirical للعالم، بل طرحاً ومحاججة معيارية تتعلق بعدالة أو كفاية المؤسسات السياسية الديمقراطية الليبرالية، إلا انّ الليبراليين في ذلك الوقت شعروا أن رؤية فوكوياما المعيارية جديرة بالدعم\الإهتمام، وبحلول مطلع القرن، كان بإمكان الليبراليين أن ينظروا إلى الإصلاحات في روسيا “بوريس يلتسين” وصين “جيانغ زيمين” ويقنعوا أنفسهم بأن فوكوياما قد كسب الحُجاج من حيث الفرضيات والأسلوب.
لم يتوافق “” هنتنجتون “” – أحد مؤسسي مجلة فورين بوليسي- مع الرأي السابق و لكنه كـ “فوكوياما” جادل بأن الانقسامات في الحرب الباردة بين الشرق الشيوعي والغرب الديمقراطي، وبين الشمال العالمي الغني والجنوب العالمي الفقير لم تعد ذات اهميّة، ولكن بينما توقع الليبرالي الدولي فوكوياما أن نهاية الحرب الباردة ستبشر بالسلام الدائم بين الدول المتوافقة على المبادئ العامة للديمقراطية الانتخابية والرأسمالية المنظمة (ما أسماه فوكوياما “صيغة الإنسان النهائية للحوكمة – “the final form of human government” ) قد توقع الواقعي ” هنتنجتون ” عالمًا يتسم بالصراع المستمر، وإن كان على محاور مختلفة تمامًا.
بالنسبة ل” هنتنجتون “، أضحى الفاعلون الجيوسياسيون المحوريون الآن هم “الحضارات”، بالمعنى الذي صاغه المؤرخ البريطاني “أرنولد ج. توينبي” في عمله الموسوعي “دراسة في التاريخ”، الذي صدر في اثني عشر مجلداً بين عامي 1934 و1961. ووفقاً ل” هنتنجتون “، فإن “خطوط الصدع”-لاحظوا الاستعارة الزلزالية المقلقة هنا-بين الحضارات ستشكّل مناطق التصدع الرئيسة في النظام العالمي لما بعد الحرب الباردة.
“ستكون الهوية الحضارية ذات أهمية متزايدة في المستقبل، وسيتشكل العالم إلى حد كبير من خلال التفاعلات بين سبع أو ثماني حضارات رئيسية. تشمل هذه الحضارات الغربية، الكونفوشيوسية، اليابانية، الإسلامية، الهندوسية، السلافية-الأرثوذكسية، الأمريكية اللاتينية، وربما الحضارة الأفريقية. ستحدث الصراعات الأكثر أهمية في المستقبل على خطوط الصدع الثقافية التي تفصل هذه الحضارات عن بعضها البعض. “
تميزت رؤية ” هنتنجتون ” للنظام العالمي الجديد، بلا شك، بقدر أكبر من التشاؤم مقارنة برؤية فوكوياما، وإن كان الاثنان يتسمان بتردد في مواقفهما، فقد اختتم فوكوياما مقاله الشهير بالتأكيد على أن ثمن السلام الدائم ستكون الرتابة التقنية technocratic tedium البيروقراطية، حيث ستتوارى سمات “الجرأة والشجاعة والخيال والطموح المثالي” التي ميَّزت الصراع الأيديولوجي، لتحل محلها عمليات “الحساب الاقتصادي، وحل المشكلات التقنية التي لا تنفد، والانشغال بالقضايا البيئية، وتلبية متطلبات المستهلك المعقدة” وبالنسبة لفوكوياما، فإن “قرون الملل” المقبلة من شأنها أن تنتج أزمة وجودية للأفراد الباحثين عن الاعتراف الاجتماعي في عالم خلا من فرص المجد السياسي. في نظام عالمي يعرف بصراع الحضارات.) إذ يروّج للديمقراطية الليبرالية جهاراً، لكنه يقرّ، في قرارة نفسه، بأنه غير واثق من مدى قوتها الحقيقية.
على النقيض من ذلك، جادل ” هنتنجتون ” بأن الهويات الجماعية، القائمة على التمييزات الثقافية المثيرة للضغائن، لن تزداد إلا رسوخاً ووضوحاُ مع تراجع الأيديولوجيات العالمية للحرب الباردة. ففي كتابه لعام 1996 الذي وسّع فيه اطروحة مقاله الأصلي استشرف توازنًا غير ثابت يستند على “الدول المركزيّة” التي تفرض هيمنتها ضمن “مجالات النفوذ” الحضارية الخاصة بها.
كما حذّز من ناحية ، أنّ “صدامات الحضارات هي التهديد الأكبر للسلام العالمي” لأن التأكيد على الاختلاف الثقافي الحتمي يشكّل أساسًا للعداء الذي لا ينفد. (كما توقع ” هنتنجتون ” أن العداء تجاه المهاجرين سيكون السمة المميزة للسياسات الداخلية في نظام عالمي يعرف بصراع الحضارات.).
ومن جهة اخرى، طالما أن الجميع في النظام الجديد يدركون حماقة محاولة فرض منظومتهم الثقافيّة على الحضارات “الغريبة”، فإن “النظام الدولي القائم على الحضارات هو الضمان الأكثر أمنًا ضد الحرب العالمية”. قد يكون العداء الثقافي بين الحضارات أمرًا لا مفر منه، ولكن مع بعض من حسن الطالع، قد يكون “الصدام” مُكوننّاُ من بعض الضجيج المزعج بدلاً من صراع دموي عنيف.
و إن لم يكن مقال ” هنتنجتون ” وكتابه اللاحق حظي بحفاوة الاستقبال ذاتها، مقارنةً مع فوكوياما، فإنه بلا شك استقطب قدراً أوفر من النقد ، إذ انتقد المؤرخون وعلماء الأنثروبولوجيا عدم تماسك مفهوم ” الحضارة” مشيرين إلى عدم اتساقه واضطرابه (التي اعترف ” هنتنجتون ” نفسه بأنها سائلة\fluid )، بينما لاحظ علماء العلاقات الدولية أن العديد من الصراعات الأكثر حدة في تلك الحقبة -مثل الحروب الشرسة بين السنة والشيعة، وكذلك عبر إفريقيا- كانت تحدث داخل الحضارات ، وليس بينها. كره العالميون والعولميون والليبراليون الكتاب أقل ، ولعلّ ذلك بسبب من تحليله للديناميكيات السياسية والأهم بسبب ما تضمنه من تخلى واضح عن الأحكام الأخلاقيّة – amoralism.
على مدى العقدين الأولين بعد نهاية الحرب الباردة، عمل النظام الدولي إلى حد كبير ضمن الإطار المعياري لفوكوياما؛ فمن منتصف التسعينيات إلى منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، لعب قادة الدول السياسيون، على مضض في بعض الأحيان، وفقًا لقواعد “الليبرالية الدولية” ، ودفعت أوروبا لتوحيد نفسها تحت الهياكل الإدارية للاتحاد الأوروبي. أما النزاعات التجارية فقد أحيلت إلى منظمة التجارة العالمية، وكانت أحكامها عموماً تُلتزم، وتمت ملاحقة مجرمي الحرب بسويّة غير متماثلة في الجديّة، ولكن عند القبض عليهم وجدوا أنفسهم يُسحبون أمام المحاكم القانونية الدولية الرسمية، سواء كانت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة (التي أُسست في 1993)، أو المحكمة الجنائية الدولية لرواندا (التي أُسست في 1994)، أو المحكمة الجنائية الدولية (التي أُسست في 2002).
وعندما قررت الولايات المتحدة شن الحرب – كما فعلت في البلقان في التسعينيات، والعراق في 2003، وليبيا في 2011 – سعت إلى الموافقة القانونية من كيان دولي ما، سواء كان الأمم المتحدة أو الناتو (على الرغم من أنها لم تسمح لرفض التصويت من ثنيها عن قرارها) بل أصر جورج دبليو بوش مرارًا وتكرارًا على أن الحرب العالمية على الإرهاب وتغيير النظام في العراق كانا يُنفذان مدعومين بمنطق فوكوياما وليس ” هنتنجتون “: “عندما يتعلق الأمر بالحقوق والاحتياجات المشتركة للرجال والنساء، لا يوجد صدام بين الحضارات”و قال. “تنطبق متطلبات الحرية بشكل كامل على إفريقيا وأمريكا اللاتينية والعالم الإسلامي بأسره. يريد شعوب الأمم الإسلامية ويستحقون نفس الحريات والفرص التي يتمتع بها الناس في كل أمة. ويجب على حكوماتهم الاستماع إلى آمالهم.”
حتى روسيا، أكبر الخاسرين جيوسياسيًا من التسوية بعد الحرب الباردة – وبالتالي ليس من المستغرب أنها كانت القوة العظمى الأكثر صخبًا في معارضتها- أظهرت احترامًا للنظام الجديد من خلال محاولة الضم الفعلي—وليس القانوني—للأجزاء المختلفة من جيرانها التي اقتطعتها (ترانسنيستريا من مولدوفا بعد 1992، وأبخازيا وأوسيتيا الجنوبية من جورجيا بعد 2008). قد تمثل هذه السوابق جميعها، بشكل أو بآخر، المديح الذي توجهه الرذيلة إلى الفضيلة، لكنها كانت في نهاية المطاف نوعاً من الإقرار بالنظام القائم.
ومن منظور فوكويامي (أي هيغلي)، تحتوي كل حقبة على رواسب من الحقبة التي سبقتها، تتجسد في شكل قوى معارضة للنظام السائد. فبحلول بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بدأت الشقوق في الهيكلية المعيارية المابعد-تاريخية تظهر. وبشكل متزايد، بدأت القوى الناشئة التي تعرف نفسها بالمصطلحات الحضارية التي وصفها “” هنتنجتون “”قبل عقدين في التعبير عن معارضتها علانية للقيم المزعومة العالمية التي تدعم النظام الدولي الليبرالي. بينما روج قادة بعض الدول الصغيرة مثل سنغافورة وماليزيا في التسعينيات لفكرة “القيم الآسيوية” (على عكس القيم الغربية)، بحلول عام 2014، كان كل من “بوتين” و”شي جين” يصفان روسيا والصين بأنهما “حضارتان” بقيم متميزة غير متسقة مع (ومن وجهة نظرهم، أفضل من) تلك الخاصة بالديمقراطيات الغربية.
وبالنظر إلى الأحداث بعد مضي عقد من الزمن، يبدو أن عام 2014 كان بالفعل نقطة التحول الحاسمة التي بدأت معها الأزمة في النظام الليبرالي الدولي تتحول إلى حالة من التعفن المتفاقم. فقد شكّل الضم الرسمي – de jure لشبه جزيرة القرم من قبل روسيا في ذلك العام قطيعة صريحة مع أحد الأعمدة الرئيسة للنظام الليبرالي الدولي، ألا وهو مبدأ عدم جواز إعادة ترسيم الحدود بالقوة. ومن اللافت أن بوتين برّر خطوته هذه على أسس “حضارية” صريحة، مدعياً أن القرم كانت دوماً جزءاً من “العالم الروسي”.
وعلى المنوال ذاته، جرت إزاحة حزب المؤتمر التعددي على يد “ناريندرا مودي” و “حزب بهاراتيا جاناتا” في عام 2014 ضمن خطاب إيديولوجي يستند إلى عقيدة “الهندوتفا”، التي ترسّخ صورة الهند كدولة حضارية متجذرة في الديانة الهندوسية (دون اكتراث لمئات ملايين الهنود غير الهندوس). أما صعود “شي جين بينغ” كزعيم أعلى غير مكترث للغموض الإستراتيجي بشأن احتمالات ليبرالية الصين بل آخذ في تبني المواجهة الإيديولوجية المباشرة، فقد شكّل هو الآخر إعلاناً عملياً عن انتهاء الرؤية الطوباوية التي طرحها فوكوياما.
وبحلول منتصف العقد الأول من الألفية الثالثة، أضحت “الموجة الثالثة” للديمقراطية أقرب إلى تمويه – False flag منها إلى بشارة بمستقبل واعد.
من هذا المنظور، يُقرأ الربع الأخير من القرن كحالة حضانة طويلة لتوقعات ” هنتنجتون “؛ إذ بات واضحاً اليوم أن ” هنتنجتون ” لم يكن مخطئًا كثيرًا بشأن ملامح النظام الدولي الناشئ بعد الحرب الباردة بقدر ما كان سابقًا لأوانه في حدسه، لقد لامس العنصر النقيض للسائد الذي سيتفاقم داخل هذا النظام، منتظرًا لحظته للظهور كأساس للنظام التالي، فلقد كان يتبلور بوضوح خلال العقد الماضي.
من زاوية ذروة التفاؤل الليبرالي الدولي في أواخر التسعينيات، يُنظر إلى لحظتنا الحالية على أنها “انتقام ” هنتنجتون “”: فلقد انتهى حلم الإجماع العالمي على الديمقراطية الليبرالية والرأسمالية العالمية المدارة تكنوقراطيّاً.
وها هم دعاة الصدام الحضاري قد صعدوا إلى الواجهة في شتى بقاع الأرض، من موسكو وبكين إلى دلهي وإسطنبول—وبالطبع في واشنطن العاصمة نفسها أيضاً. وفي ظل هذا النظام الدولي الجديد، سيفوز بالمكاسب الجريئون وأصحاب الإرادة الحازمة على حساب من يجنحون إلى الأدب والنظام؛ فبدلاً من أنّ نعاني من ملل حكم بيروقراطية ما بعد التاريخ ، سنستمتع باالإثارة الدمويّة حامية الوطيس في نظام دولي مفترس، مُدمى الأنياب والمخالب. فالقسوة ستكافأ، أما الضعف – toothlessness فسيكون عُرضة للاستغلال. و إنّي لأظن أنّ ” هنتنجتون ” يبتسم ( شامتاً) الآن في مرقده.