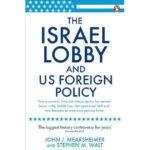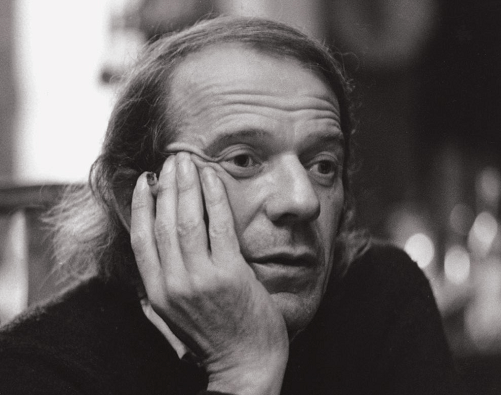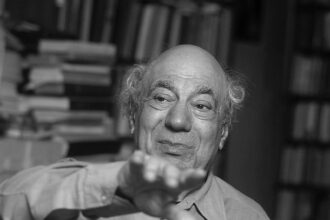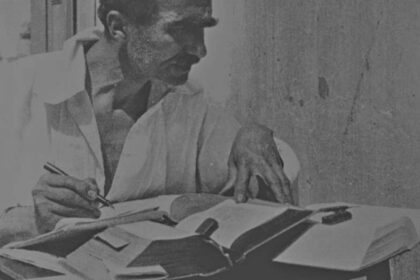في عام 1982، أجرى الفيلسوف الفرنسي جيل دولوز مقابلة مع الكاتب الفلسطيني إلياس صنبر، مؤسس “مجلة دراسات فلسطينية” (La Revue d’Études Palestiniennes). استعرض الاثنان أهمية المجلة ووجود الشعب والأرض الفلسطينية. ومع الأسف، وبعد أكثر من ثلاثين عامًا، تظل هذه النقاشات مأساويًا ذات صلة بواقعنا اليوم.
لقد انتظرنا طويلًا ظهور مجلة عربية باللغة الفرنسية، لكنها لم تأتِ من شمال إفريقيا كما كان متوقعًا، بل جاءت على يد الفلسطينيين. تتسم مجلة دراسات فلسطينية بطابعين واضحين يركزان على قضايا فلسطين التي تهم العالم العربي بأكمله. فهي من جهة تقدم تحليلات سياسية واجتماعية عميقة، بلغة هادئة ومتقنة، ومن جهة أخرى تستنهض ” corpus ” أدبيًّا وتاريخيًّا واجتماعيًّا غنيًّا إلى حدٍ كبير وغير معروف.
– جيل دولوز، 1982
دولوز:
يبدو أن شيئًا قد نضج لدى الطرف الفلسطيني. ظهر نبرة جديدة، كأنما تخطوا مرحلة الأزمة الأولى، وكأنهم وصلوا إلى منطقة من اليقين والهدوء، من “الحق”، مما يشهد على وعي جديد. حالة تتيح لهم التحدث بطريقة مختلفة، لا عدوانية ولا دفاعية، بل كمساوٍ لمساوٍ أمام الجميع. كيف تفسر هذا، في حين لم يحقق الفلسطينيون أهدافهم بعد؟
صنبر:
لقد شعرنا بهذه التغير منذ ظهور العدد الأول من المجلة. هناك من قالوا لأنفسهم: “انظروا، الفلسطينيون أيضًا يصدرون مثل هذه المجلات”، وهذا هز الصورة الجاهزة التي كانت راسخة في عقولهم. لا تنسَ أن الصورة التي كان الناس يحملونها عن المقاوم الفلسطيني كانت مجردة للغاية. دعني أشرح. قبل أن نثبت حقيقة وجودنا، كنا مجرد لاجئين في أعين الآخرين. ثم عندما أصبحت مقاومتنا قوة لا يمكن تجاهلها، وقعنا مرة أخرى ضحية صورة مشوَّهة.
تكاثرت تلك الصورة وانعزلت بلا حدود، لتُصوّرنا كعسكريين محض، وكأن كل ما نقوم به هو العمل العسكري. ولذلك فإننا نفضل أن يُنظر إلينا كمقاومين وليس كمقاتلين بمعناهم الضيق.
أعتقد أن الانبهار الذي أثارته هذه المجلة يأتي أيضًا من وجوب اعتراف البعض بأن الفلسطينيين موجودون فعلًا، وأن مجرد الإشارة إلى مبادئ مجردة لم يعد كافيًا. إذا كانت هذه المجلة آتية من فلسطين، فإنها تمثل في الوقت نفسه فضاءً يتسع للتعبير عن اهتمامات متعددة، مكانًا لا يتحدث فيه الفلسطينيون فقط، بل العرب والأوروبيون واليهود وغيرهم.
قبل كل شيء، يجب أن يدرك البعض أن وجود عمل ثقافي بهذا المستوى وبهذا التنوع الواسع في الأفق، يعني حتمًا أن هناك في مستويات أخرى داخل فلسطين رسامين ونحاتين وعمالًا وفلاحين وروائيين وبنّاكين وممثلين ورجال أعمال وأساتذة جامعيين… باختصار، مجتمعًا حقيقيًّا، وتعطي هذه المجلة تقريرًا عن وجوده.
فلسطين ليست شعبًا فحسب، بل هي أيضًا أرض. هي الرابط بين هذا الشعب وأرضه التي نُهبَت، وهي المكان الذي يتم فيه تجسيد الغياب والرغبة الجارفة في العودة. وهذه المساحة فريدة، تتكون من جميع عمليات التهجير التي عاشها شعبنا منذ عام 1948. عندما يكون عندك فلسطين في نظرك، تراقبها بدقة، تتابع كل تحركاتها الصغيرة، تسجل كل تغيير ينتظرها، تجمع كل الصور القديمة عنها، باختصار، لا تفقدها من ناظريك أبدًا.
دولوز:
إن العديد من المقالات في مجلة دراسات فلسطينية تتطرق بطريقة جديدة إلى الإجراءات التي طرد بها الفلسطينيون من أراضيهم. وهو أمر بالغ الأهمية، لأن الفلسطينيين ليسوا في وضع الشعوب المستعمرة، بل في وضع الشعوب التي أُخرجت من أراضيها، الذين أُفرغت منهم الأرض. وفي الكتاب الذي تعمل عليه، تشدد على التشبيه بـ”الهنود الحمر” الأمريكيين. إن هناك حركتين مختلفتين تمامًا في النظام الرأسمالي. في الحالة الأولى، يُحتل شعب ما على أرضه ويُستغل ليُنتج فائضًا، وهذا ما يُعرف بالاستعمار. أما في الحالة الثانية، فالأمر يتعلق بإخلاء الأرض من سكانها لدفع قفزة للأمام، حتى لو اقتضى الأمر إعادة استخدامهم كعمالة في مكان آخر. وهكذا تطورت قصة الصهيونية وإسرائيل، مثلها مثل أمريكا: كيف تصنع مساحة خالية؟ كيف تطرد شعبًا؟
في مقابلة له، يضع ياسر عرفات حدًّا لهذا التشبيه، وهو الحد نفسه الذي يشكّل أفق المجلة: يوجد عالم عربي، بينما لم يكن لدى الهنود الحمر أي قاعدة أو قوة خارج الأراضي التي طردوا منها.
صنبر:
نحن منفيون مختلفون، لأننا لم نُطرد إلى بلدان أجنبية، بل إلى استمرارية “مكاننا الخاص”. لقد نُقلنا إلى أرض عربية، حيث لا أحد يرغب في تفريقنا، بل إن مجرد التفكير بذلك يعتبر انحرافًا. هنا أشير إلى النفاق الهائل في بعض الادعاءات الإسرائيلية التي تلوم العرب على عدم “دمجنا”، وهو ما يعني في اللغة الإسرائيلية: “إبادتنا”. أولئك الذين طردونا هم الآن فجأة قلقون من عنصرية عربية مزعومة تجاهنا. هل يعني ذلك أننا لم نواجه تناقضات في بعض الدول العربية؟ لا إطلاقًا، ولكن لم تكن هذه التناقضات نتيجة كوننا عربًا، بل كانت أحيانًا لا مفر منها لأننا كنا وما زلنا ثورة مسلحة.
نحن أيضًا “الهنود الحمر” للمستوطنين اليهود في فلسطين. في أعينهم، لم يكن لدورنا سوى معنى واحد: أن نختفي. ومن المؤكد أن تاريخ تأسيس إسرائيل يعيد إنتاج العملية التي أنجبت الولايات المتحدة الأمريكية.
وهذا ربما أحد العناصر الأساسية لفهم التضامن المتبادل بين هذين البلدين. وهناك أيضًا عناصر تدل على أنه خلال فترة الانتداب، لم نكن أمام استعمار كلاسيكي تقليدي، أي التعايش بين المستوطنين والمستعمَرين. فقد أراد الفرنسيون والإنجليز وغيرها من الاستعماريات استيطان مساحات كان وجود السكان الأصليين فيها شرطًا لوجود هذه المساحات نفسها. وكان من الضروري وجود المُهيمن عليهم لكي تمارس الهيمنة. وهكذا ظهرت فضاءات مشتركة سواء أُريد ذلك أم لا، أي شبكات وقطاعات ومستويات من الحياة الاجتماعية حيث وقع “الالتقاء” بين المستوطنين والمستعمَرين. وإن كانت العلاقة مُعَدِيَة وقاسية واستغلالية، فلا ينفي ذلك حقيقة أن السيطرة لم تكن ممكنة إلا عبر الدخول في اتصال مع المحليين.
ثم جاءت الصهيونية، التي بدأت من فكرة مغايرة تمامًا، ألا وهي ضرورة غيابنا. ولم تكن هذه الفكرة مرتبطة بخصوصية المستوطنين من حيث انتمائهم إلى المجتمعات اليهودية، بل شكّلت أساس رفضنا وتشريدنا والنقل والاستبدال الذي وصفه إيلان هاليفي بدقة كبيرة. وهكذا ولد لنا هؤلاء الذين أرى أنه يجب تسميتهم بـ”المستوطنين المجهولين”، والذين وصلوا في خطوة واحدة مع أولئك الذين سماهم “المستوطنين الأجانب”. هؤلاء “المستوطنون المجهولون” الذين بنوا موقفهم على رفض الآخر بشكل شامل، استنادًا إلى خصائصهم الذاتية.
أيضًا، أعتقد أنه في عام 1948، لم تُحتل بلادنا فقط، بل بطريقة ما “اختفت”. وهكذا تحملها المستوطنون اليهود، والذين أصبحوا فيما بعد “إسرائيليين”.
لقد حشدت الحركة الصهيونية المجتمع اليهودي في فلسطين ليس على أساس أن الفلسطينيين سيغادرون يومًا ما، بل على أساس أن البلد كان “فارغًا”. بالطبع، كان هناك من لاحظ العكس لدى وصولهم وكتب عنه! ولكن الغالبية العظمى من هذا المجتمع تعاملت مع السكان الذين تلامسهم يوميًّا وكأنهم غير موجودين. وكانت هذه العمى ليس جسديًّا، فلم يكن أحد يخدع نفسه، لكن الجميع كانوا يعرفون أن هؤلاء الموجودين اليوم “على وشك الاختفاء”، وأن اختفائهم لن ينجح إلا إذا تم التعامل معه كما لو كان قد تم بالفعل، أي عبر عدم “رؤية” وجود الآخر رغم وضوحه.
ولتحقيق ذلك، لعبت الحركة الصهيونية دائمًا على رؤية عنصرية جعلت من اليهودية أساسًا للطرد ورفض الآخر. وقد ساعدتها في ذلك الاضطهادات في أوروبا التي قادها أناس عنصريون آخرون، فوجدوا فيها تأكيدًا لرؤيتهم الخاصة.
بل نحن نرى أن الصهيونية سجنت اليهود، وجعلتهم أسيرًا لهذه الرؤية التي أصفها. أقول إنها جعلتهم أسيرًا، وليس أنها جعلتهم كذلك في لحظة زمنية معينة. وأقول ذلك لأن الموقف تطور بعد الحرب العالمية الثانية، وتحول إلى نوع من “المبدأ الأبدي الزائف” الذي يقول إن اليهود هم دائمًا وأبدًا “الآخر” في كل المجتمعات التي يعيشون فيها.
لكن لا يوجد شعب أو مجتمع يستطيع – ولحسن حظه – أن يحتل باستمرار موقع “الآخر” المرفوض والمُدان.
اليوم، “الآخر” في الشرق الأوسط هو العربي، هو الفلسطيني. وأقصى درجات النفاق واللامبالاة هو أن تطلب منه القوى الغربية، وهي تأمر باستمرار بـ”اختفائه”، ضمانات. لكننا نحن من يحتاج إلى ضمانات ضد جنون القادة العسكريين في إسرائيل.
ورغم ذلك، قدمت منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الوحيد الشرعي لنا، حلها للصراع: دولة فلسطينية ديمقراطية، ستُسقط الجدران الفاصلة بين جميع السكان، بغض النظر عن هوياتهم.
دولوز:
لدى مجلة دراسات فلسطينية بيانها التأسيسي، الذي يظهر في الصفحتين الأولى والثانية من العدد الأول: “نحن شعب مثل الشعوب الأخرى”. إنه صرخة تحمل معاني متعددة. أولًا، هي تذكير أو نداء.
يُعاب على الفلسطينيين باستمرار رفضهم الاعتراف بإسرائيل. يقول الإسرائيليون: انظروا، يريدون تدميرنا. لكن الفلسطينيين أنفسهم قاتلوا لأكثر من خمسين عامًا ليُعترف بهم.
وثانيًا، تأتي هذه الجملة كرد على البيان الإسرائيلي الذي يقول: “نحن لسنا شعبًا مثل الشعوب الأخرى”، بسبب تفوُّقنا الإلهي وعظم الاضطهاد الذي تعرضنا له. ومن هنا تأتي أهمية النصين في العدد الثاني من المجلة حول الهولوكوست، من كتابات إسرائيلية، حول ردود فعل الصهاينة تجاه الهولوكوست، ومعنى الحدث بالنسبة لإسرائيل، مقارنةً بالفلسطينيين والعالم العربي بأسره الذين لم يكونوا مشاركين فيه.
طالبةً “المعاملة الاستثنائية”، ترسخ دولة إسرائيل نفسها أكثر فأكثر في حالة اعتماد اقتصادي ومالي غير مسبوق على الغرب، لم تعرفها دولة أخرى من قبل (بوعز إيفرون). ولذلك يتمسك الفلسطينيون بالمطلب المعاكس: أن يصبحوا ما هم عليه حقًّا، أي شعبًا “طبيعيًّا” تمامًا.
في مواجهة التاريخ الذي يُكتب بلغة النهايات والخراب، هناك نوع آخر من التاريخ يُبنى فقط على ما هو ممكن، وعلى تعدّد الممكنات، وعلى غنى اللحظة بفضاءات لا حدود لها من الخيارات والاحتمالات. أليست هذه هي الرسالة التي تحاول “المجلة” إيصالها، خاصةً في تحليلاتها للوقائع الجارية؟
صنبر:
بالتأكيد. إن هذه الفكرة البسيطة جدًّا والمليئة بالمعنى – تذكير العالم بوجودنا – ستجعل مهمة أولئك الذين يأملون في اختفاء الشعب الفلسطيني بالغة الصعوبة. لأنها تقول ببساطة إن لكل شعب حقًّا في الحقوق. إنه تصريح بديهي، لكنه قوي لدرجة أنه يمثل نقطة البداية والنهاية لكل نضال سياسي. خذوا الصهاينة، ما الذي يقولونه في هذا الشأن؟ لن تسمعهم أبدًا يقولون إن للشعب الفلسطيني “لا حق له في شيء”، فالقوة لا يمكنها دعم مثل هذا الموقف، وهم يعلمون ذلك جيدًا. على العكس، ستسمعهم يقولون بكل وضوح: “ليس هناك شعب فلسطيني”.
بقلم جوردن سكينر / 8 أغسطس 2014