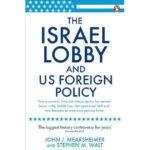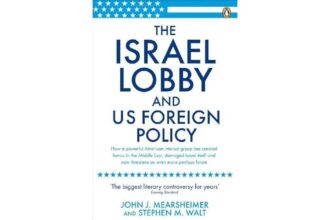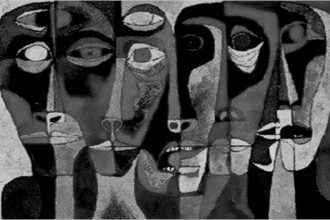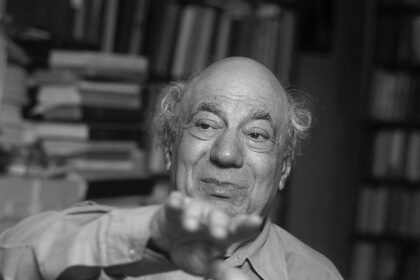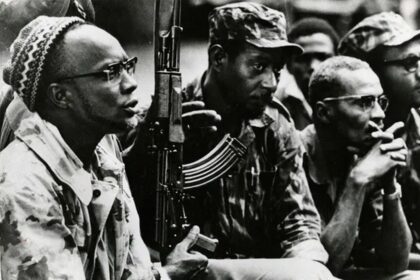( نقدم هنا سلسلة من الترجمات © من أحد أحدث كتب البروفسور ” Ilan Pappé – إيلان بابيه ” :
Lobbying for Zionism on Both Sides of the Atlantic والتي ظهرت طبعته الإنجليزيّة الأولى سنة 2024 والكتاب ضخم كمّاً ونوعاً، وسنعمل في “أطراس” على ترجمة منتخبات منه، وهذه ترجمة من الباب المعنون بـ : Lord Shaftesbury and Colonel Charles Churchill هو باب من أبواب الفصل الأول المعنون بـ : The Christian Harbingers of Zionism. ويناقش فيه “بابيه” الجذور التاريخيّة الاستعماريّة للصهيونيّة ودور بعض الشخصيات التي غفل عنها القاريء العربي لندرة المواد حولها وعنها في صهر الصهيونيّة كفكرة دينيّة في بوتقة المصالح الإمبراطوريّة والاستعماريّة الإنجليزيّة، وندعو القراء إلى المطالعة المتأنيّة للمواد )
الجذور الاستعماريّة للصهيونيّة
بدأ شافتسبري ( أنطوني آشلي-كوبر ” Anthony Ashley-Cooper” إيرل شافتسبري السابع ) عمله لصالح الصهيونية قبل وقت طويل من توليه رئاسة ” جمعية البريطانيين والويليزيين للكتاب المقدس – British and Foreign Bible Society ” للكتاب المقدَّس، وقبل أن تصبح الصهيونية مشروعًا يهوديًا. فقبل أن يتولى منصبه في تلك الجمعية، كان رئيسًا لجمعية أخرى هي “الجمعية اللندنية لترويج المسيحية بين اليهود”، وقد كان يُدير فرعها في فلسطين القنصل البريطاني في القدس جيمس فين- James Finn.
وقد اُفتُتحت هذا القنصلية عام 1838 بفضل جهود شافتسبري في إقناع الحكومة البريطانية بأن فلسطين ذات أهمية استراتيجية للإمبراطورية، إذ كان على يقين بأن أيام الدولة العثمانية باتت معدودة، وأن السباق للاستحواذ على بقاياها قد بدأ بالفعل.
وفي رأيه، كانت فلسطين، إلى جانب مصر وولايات سوريا والهلال الخصيب (الذي سيشمل العراق لاحقًا)، حلقة حيوية تصل لندن بمستعمراتها في الشرق. وما أن اُفتُتحت القنصلية حتى وصل وفدٌ خاص أرسلته كنيسة اسكتلندا، مكلَّفًا بمهمة التحقق من استعداد اليهود المقيمين في فلسطين آنذاك لاعتناق المسيحية (كان هناك مجتمع صغير من اليهود المتدينين في مدن مثل القدس وصفد والخليل وطبرية، لم يكن من بينهم من يهتم بالمسيحية أو بعقيدة الألفية القياميّة – millennialism). وكان أحد أعضاء الوفد وهو ” ألكسندر كيث ” قد أصدر مذكرات سفر أطلق عليها عنوانًا بليغًا هو “برهان النبوءة”، ويُرجَّح أنه كان أوّل من صاغ عبارة ” أرض بلا شعب لشعب بلا أرض” (وكان ابنه من أوائل من التقطوا صورًا لفلسطين).
بدأ شافتسبري عام 1839 يُكثف جهوده للدفع بعودة اليهود إلى فلسطين، أو كما عبّر عنها: ” إعادة اليهود إلى الأرض المقدسة “. وناشد البرلمان البريطاني دعم المشروع، مستشهدًا بالنصوص المقدسة التي تؤكد – وفق تأويله – أن منتصف القرن التاسع عشر هو الوقت الذي يقترب فيه نهاية العالم، وأن عودة اليهود إلى فلسطين قد تُعجِّل به. وكان على وجه الخصوص يكثر من الاستشهاد بـ ” سفر الأخبار ” ، مدعيًا أنه حافل بالأدلة على “لبعث إسرائيل” المستقبلية. ولا بد أنه كان مبتهجًا عندما قرأ في صحيفة “التايمز” أن الحكومة البريطانية تدرس دعم هذا المسعى رسميًا.
وإدراكًا منه لميل كثير من أعضاء البرلمان إلى المنفعة والمصلحة، أورد شافتسبري حججًا دنيوية واستراتيجية لصالح هذا المشروع. ولم تكن مهمته سهلة، إذ كانت الإمبراطورية البريطانية حريصة على الحفاظ على وحدة الدولة العثمانية، خشية أن يؤدي انهيارها إلى حرب أوروبية شاملة.
جادل شافتسبري بأن على بريطانيا أن تُعدّ نفسها لفشل هذه السياسة، فسواء رغبت لندن أم لم ترغب، كانت هناك – على حدّ قوله – تحوّلات جذرية قوية تتكاثف لتُعجِّل بانهيار الدولة العثمانية، وأهمُّها على الإطلاق تصاعد الزحف الروسي جنوبًا، في توسّع للنفوذ يُنهي الأقاليم واحداً تلو الآخر. كما أشار إلى والي مصر “محمد علي” الذي رآه خطرًا حادًّا يهدد وجود السلطنة العثمانية ذاته؛ فقد احتلّ حاكم القاهرة الطموح فلسطين وسوريا بالفعل، وبدت عزيمته متجهةً صوب إسطنبول. فكان لهذا النوع من التحليلات صدى لدى رئيس الوزراء البريطاني، اللورد “بالمرستون الثالث (هنري جون تمبل)” الذي تزوّج والدة زوجة شافتسبري فصار حماه. غير أن بالمرستون، على خلاف شافتسبري، آثر – مع تأييده لفكرة الدولة اليهودية – أن يدعم فكرة فلسطين العثمانية-اليهودية، لتُعدّ جزءًا من مسعًى أوروبي لكبح الطموحات التوسعية المصرية.
و قد كتب شافتسبري إلى حميه :
“إن بلادًا بلا أمة تحتاج إلى أمة بلا بلاد… فهل ثمة من يُلبّي هذا الوصف؟ بلى، إنهم السادة القدامى والشرعيون لتلك التربة: اليهود!” (…) وتُخبرنا مذكراته أن فلسطين – في نظره – لم تكن وحدها “بلادًا بلا أمة “، بل إن سورية الكبرى بأسرها كانت تفتقر إلى كيان قومي، ومن ثم تستحق الامتصاص في الدولة اليهودية المستقبلية:
” ستصبح هذه الأقاليم الشاسعة الخصيبة قريبًا بلا حاكم، بلا سلطة معروفة ومعترف بها تدّعي السيادة عليها. ولا بد أن تُسند هذه الأرض إلى أحد… بلادٌ بلا شعب، والآن، بحكمته ورحمته، يوجّهنا الله إلى شعب بلا بلاد “.
لكن هناك محاولة أخرى، مختلفة تمامًا، لتيسير عودة اليهود إلى فلسطين، هذه المرة بالتعاون مع ” محمد علي ” لا بمواجهته. قادها العقيد ” تشارلز هنري تشيرتشيل -Charles Henry Churchill ” (1807-1869)، جدّ “ونستون تشرتشل”.
كان تشيرتشيل قنصلًا بريطانيًا في دمشق، وكان دوره الرئيسي التودد إلى الطائفة الدرزية في لبنان لجعلها عميلة لبريطانيا، في وقت كانت فيه القوى الإمبراطورية الأوروبية تبحث عن ذرائع للتدخل لحماية الأقليات المحلية في شؤون الدولة العثمانية. والدروز، لا يزالون حتى اليوم من أبرز المجموعات الدينية في شرق المتوسط، يعيشون في لبنان وسوريا والأردن وإسرائيل، ولقد انفصلوا كطائفة مستقلة عن بقية المذاهب الإسلامية في القرن الحادي عشر، وبحلول أوائل القرن الثامن عشر سادوا جنوب لبنان اجتماعيًا وسياسيًا، فصاروا قوةً لا يُستهان بها في السياسة المحلية وفي مواجهة الدولة العثمانية. اقترح تشيرتشيل في أربعينيات القرن التاسع عشر، أثناء خدمته في دمشق، خطة سياسية لإنشاء دولة يهودية في فلسطين.
عَرَض تشيرتشيل خطّته على السير “موسى مونتيفيوري – Sir Moses Montefiore” رئيس “مجلس نوّاب اليهود الإنكليز”، وواحد من أوائل المتبرّعين الموسّعين لمشروع الصهيونية في فلسطين.
كان مونتيفيوري أوّل من استخدم “مجلس النوّاب” لأجل القضية التي ستصبح لاحقًا تُعرف بالصهيونية. أُنشئ المجلس عام 1760 على يد الجالية السفاردية في لندن (أما الأشكناز فكانت لهم هيئة منفصلة: “اللجنة السرّية للشؤون العامّة”). وفي عقد 1810 اندمجت الهيئتان في “اللجنة اللندنية للنوّاب اليهود البريطانيين”، وكان كلّ همّها يتركّز على شؤون الجالية اليهودية في بريطانيا.
لكن التحوّل الصهيوني لمونتيفيوري سوّغ في نظره، بعد حادثة نادرة من ” افتراء الدم” وما تبعها من شغب في دمشق، فعام 1840، عُثر على عظام راهب كاثوليكي وخادمه المسلم في الحيّ اليهودي من المدينة، فاتُّهمت شخصيات بارزة من اليهود باختطافهما وقتلهما واستخدام دمائهما في خبز “المَسّات -matzos” (الخبز غير المُخمّر) لعيد الفصح. وقد دعم القنصل الفرنسي هذه المزاعم، وصدّقها والي المدينة، فأدّت إلى تحقيق وحشي وأُعدِم عدد من اليهود، فسافر مونتيفيوري بنفسه في مهمة لإنقاذ من تبقّى من السجناء اليهود.
لكن لا ينبغي المبالغة في تأثير الدوافع الإنسانية، فقد دعم مونتيفيوري المشروع الصهيوني بدافع براغماتي صرف: إذ كان من المتوقّع أن ينتهي الحكم المصري في بلاد الشام قريبًا، ما يعني ضرورة إعادة رسم خرائط المنطقة من جديد. ولهذا بدا له “نداء” تشيرتشيل منطقيًا، ففي رسالة طويلة جدًا حثّه فيها العقيد على قيادة حملة لإعادة اليهود إلى فلسطين:
“ليتقدّم أبرز رجال الجالية إلى رأس الحركة، وليجتمعوا، ويتشاوروا، ويُقدّموا الالتماسات\العرائض. وعلى الحقيقة، ينبغي أن تكون الضجة متزامنة في أنحاء أوروبا كلّها”.
حثّ تشيرتشيل المتبرّع اليهودي على استثمار ثروته الخاصة في ” إحياء سوريا وفلسطين” واستعادة السيادة اليهودية على الأخيرة، مما سيؤدي إلى خضوع بقية سوريا ” للحماية الأوروبية “، وقد اكتست الرسالة بلغة إنجيلية واضحة: ” قد سرى فينا هذا الحس وتعاظم حتى صار فينا طبيعةً ثابتة : إنّ فلسطين تستعيد أبناءها “.
كان مخطّط تشيرتشيل يقتضي بحشد الدعم عبر عريضة تُوقّع من الجالية اليهودية القائمة بالأصل في سوريا وفلسطين، وعلى أساسها يتمّ التوجّه إلى القوى الأوروبية (قبل التفاوض مع الدولة العثمانية). وانتظر مونتيفيوري ليرى إلى أي حد يمكن أن يذهب تشيرتشيل. فتمكّن القنصل المتحمس من الحصول على موافقة “محمد علي” على الخطة – أو على الأقل استعداده لبحثها أكثر – لكن موقفه أمسى عديمَ الجدوى لأنه سرعان ما فقد حكم فلسطين.
ويستحق تشيرتشيل اهتمامنا، لأنه أرسى الدعائم التي ستؤدي لاحقًا إلى “وعد بلفور”. فقد اقترح – بوضوح نبوئي – أن يُكلَّف بهذا المشروع ” موظف عام – public officer” يتولى التنسيق بين “وزير الخارجية واللجنة اليهودية التي تُجري المفاوضات”. ومع أنّه لم يكن هو من نُفّذ هذا الدور في النهاية، لكن تلك كانت المنهجية التي اُختيرت فعلًا.
في هذه المرحلة من التاريخ، يمكننا رصد وجود جماعتَي ضغط مختلفتين في بريطانيا، كانتا تعملان آنذاك – وإن لم يكن دائمًا – بتنسيق متوازٍ ؛ الأولى جماعة دينية تدعو إلى فلسطين يهودية، متحركة بدافع اعتبارات أخروية- قياميّة، بينما الثانية تضغط من أجل فلسطين بريطانية، متحفزة بآمال جيوسياسية. وقد كان نجاح الأولى مرهونًا بقوة الثانية.
في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، كانت الاستراتيجية الرسمية لبريطانيا قائمة على الحفاظ على وحدة الدولة العثمانية، ومن ثم لم تكن هناك خطط حقيقية لفلسطين بريطانية. ورغم هذا، كانت جماعة الضغط الدينية تسعى للتحالف مع أقلية من صانعي القرار الرئيسيين الذين عارضوا هذا الإجماع، ولم يكونوا يرغبون في بقاء الدولة العثمانية، بل كانوا يصلّون لسقوطها. كان هؤلاء جزءًا من تحالف أوسع لإقامة شرق أوسط بريطاني يحلّ محل العثماني.
ولكن حتى عندما ظلت السياسة قائمة على الحفاظ على وحدة الدولة العثمانية، ظلت هناك مساحة كافية لتعميق التورط البريطاني في فلسطين، وهو تورط نستطيع اليوم القول إنه أرسى، بأثر رجعي، دعائم فلسطين يهودية. وكان المنهج الرئيس لذلك هو انتزاع أكبر عدد ممكن من ” الامتيازات” من الدولة العثمانية – أي تلك الباقة من التنازلات والتراخيص التي تُمنح لرعايا بريطانيا تحت ضغط حكومة لندن.
فعندما كانت الدولة العثمانية في أوج قوتها، كانت هذه الامتيازات عبارة عن عقود ثنائية مع القوى الأوروبية تسهّل عبور وتجارة التجار الأوروبيين، لكنها تحولت لاحقًا إلى مجموعة امتيازات متفق عليها لرعايا الدولة العثمانية من الأوروبيين. وفي فلسطين، مكّنت هذه الامتيازات البعثات المسيحية من إنشاء وتوسيع مشاريع خيرية مثل المستشفيات، وزيادة عدد أفراد الجالية البريطانية، وإرسال بعثات استطلاع لمسح البلاد.
وتشهد كثرة الرحلات البريطانية المدوّنة في القرن التاسع عشر على هذا النفوذ المتزايد داخل فلسطين. وكما نعرف من تجربة أفريقيا، فإن هذه المذكرات والمسوح عادة ما سبقت الاستيلاء الإمبراطوري. ومن ثم، فإن زيارة المكان، والتطلع إلى عودة اليهود إليه، كانا مرتبطين ارتباطًا وثيقًا بتوسع النفوذ البريطاني في العالم العربي ككل، وفي فلسطين على وجه الخصوص.
ولإقناع حلفاء بريطانيا في أوروبا بأن انتزاع فلسطين من أيدي الدولة العثمانية هو ضرورة دينية واستراتيجية في آنٍ واحد، كانت الحاجة ملحة لدى اللوبيات المسيحية واليهودية الناشئة للصهيونية إلى وجود أفراد في مواقع قوة يصلون من خلالهم إلى صانعي السياسات القادرين على ترجمة هذه الرؤية إلى واقع.
وقد سبق أن التقينا باثنين منهم: شافتسبري وتشرتشيل، لكنهما لم يكونا الوحيدين من روّاد الصهيونية المسيحية. فقد انضم إلى هذا التيار شخصيات بارزة أخرى، من أبرزهم ” السير جورج غولر – Sir George Gawler “، بطل معركة واترلو – ثم الحاكم لجنوب أستراليا- حيث اختبر عن قرب ماهيّة الاستعمار الاستيطاني الذي كان ستمارسه الإمبراطورية لاحقًا في فلسطين (وقد أُقصي بعد فترة وجيزة بسبب سوء إدارته للمستعمرة الأسترالية).
في عام 1848، كتب ” غولر ” :
” سأكون فرحًا حقًا لو رأيت في فلسطين حامية قوية من اليهود تستقر في مستوطنات زراعية مزدهرة، وعلى أهبة للدفاع عن جبال إسرائيل ضد أي معتدٍ،ولا أتمنى في هذه الحياة شيئًا أعظم مجداً من أن أكون شريكًا في مساعدتهم على ذلك”.ولقد ذهب ” غولر ” أبعد من كثير من الروّاد الأوائل عندما أنشأ “صندوق استعمار فلسطين” لمساعدة المستوطنين الصهيونيين الأوائل في وطنهم الجديد.
وسواء كانوا مسيحيين أو يهودًا، فإن مناصري الصهيونية أسمعوا أصواتهم لصانعي السياسات منذ وقت مبكر جدًا – وهو تكتيك ما زال ناجحًا حتى اليوم، على عكس الحركة الوطنية الفلسطينية التي تعاني حتى الآن لكسب موطئ قدم داخل النخبة السياسية الدولية – ومن أبرز المنتسبين المهمين للمنادين الأوائل كان ” بنيامين دزرائيلي – Benjamin Disraeli ” ، رئيس الوزراء البريطاني منذ عام 1868، الذي كتب في عام 1877 مقالًا تنبأ فيه بقيام أمة يهودية من مليون نسمة في فلسطين خلال خمسين عامًا.
وكما سبق القول، كان اللوبي في أقوى حالاته عندما التقى حلم فلسطين بريطانية بحلم فلسطين يهودية. مثّل دزرائلي – في هذا السياق – كلا الدافعين معًا، فإلى جانب رغبته في رؤية اليهود هناك، أصبحت فلسطين ذات أهمية في نظره منذ أن قاد الاستيلاء الناجح على شركة قناة السويس، وهو ما غيّر القيمة الاستراتيجية لفلسطين. أضف أنّه كان يبحث عن مشاريع إمبراطورية ناجحة أخرى، إذ لم تسر الحروب الإمبراطورية في صالحه كثيرًا، إذ نجح البريطانيون في انتزاع انتصار متداعٍ من ” الزولو ” في جنوب إفريقيا بعد خمسة أشهر من القتال وخسائر بشرية فادحة، وعلى الرغم من فوزهم في الحرب الأفغانية الثانية عام 1879، فإن المبعوث البريطاني في كابُل اغتيل رغم ذلك.
وإلى جانب السياسيين، كان لدعم أهل الأدب والفكر دورٌ محوري في هذا الجهد المكثَّف. من أبرز هؤلاء كانت ” جورج إليوت – George Eliot” التي تأثرت بتربيتها المسيحية الإنجيلية. وفي روايتها الأخيرة -” دانيال ديروندا – Daniel Deronda”- عبّرت عن تطلعها إلى “إعادة إقامة دولة يهودية”، حيث يقرر البطل أن يكرِّس حياته لهذه القضية.
يقال إن هذا الكتاب، على وجه الخصوص، صهيّن – Zionised أحد أبرز المثقفين اليهود؛ ” إليعازر بيرلمان – Eliezer Perlman” الذي غيّر اسمه إلى ” إليعازر بن يهوذا ” ويُعتبر والد اللغة العبرية الحديثة، التي أصبحت لاحقًا لغة التخاطب الرئيسية بين المستوطنين الصهاينة الأوائل، ثم في دولة إسرائيل. (…)
في مطلع القرن اللاحق، ستتشكل دوافع اللوبي الصهيوني المسيحي من قوتي دفع رئيسيتين:
الأولى؛ هي الشعور الملح بأن اليهود يحتاجون إلى إنقاذ وسط تصاعد حملات معاداة السامية المتزايدة الوحشية، وفي بعض الأحيان مذابح كاملة – كانت غالبًا تُدار أو تُغطى من السلطات المحلية، لكنها لم تكن لتتم دون مشاركة حماسية من عامة الشعب، بدافع صريح لطرد اليهود من أوروبا، خاصة أوروبا الشرقية.
والثانية؛ رغبة جامعة في التهام ممتلكات الدولة العثمانية، مدفوعة بانهيار السياسة المتحفظة تجاه الإمبراطورية التي كانت سائدة في أوروبا. فقد خشي كثير من القادة الأوروبيين أن يسفر سقوط الدولة العثمانية عن حرب أوروبية شاملة على غنائمها. ومن ثم، بينما كانت هناك رغبة في الاستيلاء على بعض أراضيها وإضعافها كقوة عالمية، وكانت هناك أيضًا رغبة متزامنة في إبقائها موحدة. لكن هذا التوجّه الحذر أُلقي بمهب الرياح؛ أما المتطلعون إلى القيامية الألفيّة – millenarists فقد رأوا في ذلك مؤشرًا آخر على أن الوقت حان لاحتلال أراضي شرق المتوسط.
لكن اللوبي الصهيوني لم يقتصر على الإنجيليين المسيحيين؛ فقد بدأ اليهود، الذين كانوا يبحثون عن مخرج من اضطهاد بدا مستعصيًا في أوروبا، بالتجمع حول فكرة دولة خاصة بهم – مع رؤى تمتد من يوتوبيا اشتراكية على أرض فلسطين إلى دولة حديثة في تحالف مع القوى الإمبراطورية الغربية. ولم تكن الصهيونية مجرد رد فعل على معاداة السامية، إذ حُمِّس بعض مفكريها الأوائل بصعود القومية الرومانسية و علمنة – secularisation المجتمعات الأوربيّة في منتصف القرن التاسع عشر، إثر الثورة الفرنسية والتنوير.
ومن ثم كانت الصهيونية محاولة لامتلاك نسخة يهودية من القومية الرومانسية والعلمنة الحديثة، والتي رأى كثير من هؤلاء المفكرين أنها تملك فرصة أفضل للنضج في أرض فلسطين التوراتيّة من أي مكان آخر في أوروبا.
ولم يمض وقت طويل حتى وصل أول المستوطنين الصهاينة إلى فلسطين، وكان مُبتدأ ذلك هو مذابح عام 1881 في جنوب غرب الإمبراطورية الروسية، التي أعقبت اغتيال الإسكندر الثاني؛ فقد أدت إلى تدمير واسع لممتلكات اليهود، ووردت تقارير عن اغتصاب نساء يهوديات. وقد آمن اليهود في تلك المناطق بتورّط الحكومة، وفقدوا الأمل في التحرر تحت النظام القيصري، فمالوا إلى استراتيجيات سياسية بديلة، من بينها الصهيونية.
فوصل أول المستوطنين في 6 يوليو 1882، كانت المجموعة مكوّنة من أربعة عشر يهوديًا روسيًا وصلوا ميناء يافا، وسرعان ما بدأوا يعملون كعمال زراعيين في المجتمعات حديثة التأسيس. وقد دعم مفكرون يهود من أوروبا الوسطى هذه المحاولات الوليدة من بعيد، وكان من أبرزهم الصحفي والكاتب المسرحي ” تيودور هرتزل ” – الذي يُحتفل به اليوم كمؤسس الصهيونية – وتحت قيادته، وبمساعدة منظمات صهيونية كثيرة تكاثرت بعد تصاعد معاداة السامية في أوروبا، بدأت الصهيونية تتبلور كحركة مؤسسية.
تمكّن اليهود الصهاينة من عقد أول مؤتمر لهم في بازل، سويسرا، عام 1897، بحضور 208 مندوبين من سبع عشرة دولة، وتبعه مؤتمرات كثيرة ،وحتى قبل انعقاد المؤتمر، كان قادة الحركة الجديدة يبحثون عن زعماء مؤثرين ونخب سياسية في أوروبا والدولة العثمانية لدعم إقامة دولة يهودية في فلسطين. وبينما كان المستوطنون يرسّخون “وقائع على الأرض”، كان القادة يسعون لاكتساب شرعية دولية لها.