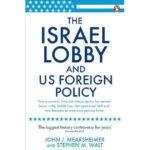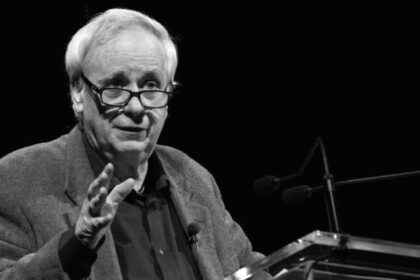( توطئة : ماهي سياسات إدارة الموت؟ الـ ” Necropolitics ” وما صلتها بحالات القتل الجماعي والإبادات الممنهجة والحروب ؟ والتي في مجملها وجمعها لا تحصد إلا أرواح الفقراء والمهمشين من غير المستفيدين في النظام الاقتصادي الراهن وابناء المستعمرات السابقة أو الحاليّة – ” فلسطين” – ؟ وهل تمتد جذور سياسات الموت تلك في العنصريّة الغربيّة؟ وكيف؟
في هذا الترجمة © لمقال يوصّف مفهموماً جديداً هو الـ ” Necropolitics ” نعتقد أنّ القراء العرب قد يتعرفون عليه – بلغتهم- للمرة الأولى، ومع أنّ المقولات التي ينتجها هذا المفهوم قد تبدو صادمة، إلا أنّ حالة العالم وسياسات القوة المهيمنّة لتوقظ في القاريء شكاً معقولاً يؤكد صلاحية جزئيّة أو كاملة للمفهوم. نشر المقال بعنوان :Achille Mbembe: Necropolitics للكاتب : Antonio Pele )
أشيل مبيمبي : سياسة إدارة الموت أو الـ Necropolitics
لقد أضحت إدارة\سياسة الكتل البشرية اقتصاديًّا وسياسيًّا من خلال مواجهتها للموت ظاهرة عالميّة، إذ تُظهر وتكشف الحروب، والإبادات الجماعيّة، وأزمة اللاجئين، والإبادة البيئيّة، وعمليات الإفقار وانعدام الاستقرار والأمان الاقتصادي والاجتماعي – precarization المعاصرة كيف تُدار وتُساس كتلٌ متناميّة من الأفراد اليوم خلال تعرّضهم\مواجهتهم المباشر وغير المباشر للموت.
ولتفكيك وتحليل هذه الإجراءات، أطلق ” أشيل مبيمبي – Achille Mbembe ” مفهوم ” سياسة\ات إدارة الموت -Necropolitics” [ يتكون المفهوم\المصطلح من شقين الأول Necro والذي يعني الموت والتحلل ، ومنه Necropolis أي المدافن الواسعة و Politics بمعنى سياسي، ونفضل هنا الترجمة التي قدمناها بدلاً من تعقيدات تراكيب أخرى قد تفقد القاريء اتساق المعنى ودلالته] و قد قدّم هذا المفهوم أوّلًا في مقال نُشر عام 2003 يحمل الاسم نفسه، ثم في كتاب “سُبل العداوة – Politiques de l’inimitié ” الصادر عام 2016، والذي تُرجم ونُشر بالإنكليزية عام 2019 تحت عنوان ” Necropolitics “، وعبر هذا المفهوم الأخير يستكشف مبيمبي ويؤصل مفهوم ” السياسة الحياتويّة -biopolitics ” والتي يمكن الذي وضعه فوكو ( نفضل هذه اللفظة على الترجمة السائدة بالحيويّة، فقد رمى فوكو إلى إدارة الحياة المعاشة) .
فقد لاحظ ميشيل فوكو ، في المحاضرة الأخيرة من ” يجب الدفاع عن المجتمع” [سلسلة دروس لفوكو] وفي الفصل الأخير من “تاريخ الجنسانية” (المجلّد الأوّل)، كيف يمكن للسياسة الحياتويّة، أيّ السلطة الفاعلة في الحياة، أن تتحوّل إلى شكل قاتل من السلطة؛ فهي ليست فقط ” إدارة محسوبة للحياة ” بل كذلك ” سلطة لتعريض سكانٍ بأكملهم للموت” .
فمستندًا إلى تجارب النازيّة والستالينيّة المروّعة وإلى التهديد النووي العالمي، أبرز فوكو كيف لكتل بشرية ان تُزال\تمحى باسم حماية وبقاء أمة أو شعب أو طبقة.
كما أشار إلى أنّ العنصريّة أصبحت الأداة السياسيّة التي تُمكّن التقسيم البيولوجي للنوع البشري وتبرّر إبادة من يُعتبَرون أدنى. وأكّد فوكو أنّ العنصريّة الحديثة تطوّرت مع ” الإبادة الاستعماريّة ” كي يُمكن تبرير الحق في انهاء الحياة. وقد استقرأ “جورجو أغامبن” و “روبرتو إسبوزيتو ” هذه الملاحظات الفوكويّة – عبر مفهومَي ” الإنسان المقدَّس-homo sacer ” و “سياسة الموت – thanatopolitics ” -مشددين ، كل من جانبه، على الحق السيادي المطلق في القتل بلا عقاب مُستَتبع، وعلى وجود المبرّرات البيولوجيّة/المرضيّة – biological/pathological لإبادة\إفناء البشر.
أمّا ” سياسة إدارة الموت – necropolitics ” عند “مبيمبي” فتتطوّر إلى مقاربة معرفيّة\نظريّة هامة إذ تستند إلى التحليلات\القراءات الفوكويّة وإلى مقاربة ما-بعد-استعماريّة (غالبًا بأثر من فرانز فانون)، وإذ تصوّر “سياسة إدارة الموت” بوصفها الصياغة\الهندسة السياسيّة – political making للفضاءات والذوات في الفترة الوسطيّة بين الحياة والموت. فـ”المستعمرة – colony ” و ” المزرعة القائمة على العمالة\العبيد – plantation ” بشكل خاص ولدّتا الممارسات النكرو-سياسيّة ( necropolitical) – التي تعزّزها سيادة البيض – والتي ما تزال مستمرة إلى اليوم.
إخضاع الحياة لسلطة الموت
تتضمّن “سياسة إدارة الموت” “إخضاع الحياة لسلطة الموت” إذ – على حدّ تعبير مبيمبي – في ” عالمنا المعاصر” تُستخدم أنواع متعدّدة من ” الأسلحة لتحقيق أقصى تدمير للأشخاص وخلق مدارات-للموت (death-worlds)، لتخليق أشكال جديدة وفريدة من الوجود الاجتماعي يُخضَع فيها كم عظيم من السكان لظروف حياة تُكسيهم صفة الأموات الأحياء- living-dead “وتُنجز ” مدارات-الموت ” هذه من خلال ثلاثة عوامل رئيسة سأعرّفها لاحقًا.
ومن جهة فإنّ “سياسة إدارة الموت” تقتضي “اقتصاد إدارة الموت -necroeconomy ” إذ تنتِج الرأسماليّة الحديثة فائض سكان لا يمكن استغلالهم بعد الآن، لكن يتعيّن ضبطهم عبر تعرّضهم للمخاطر والأخطار المميتة. وربما تكون “الأزمة المناخيّة” المثال الأوضح ” لاقتصاد إدارة الموت” إلى جانب التدمير الجاري للمنافع\المؤسسات الاجتماعيّة وللحقوق العامة.
ومن جهة اخرى؛ تعتمد “سياسة إدارة الموت” على حَشر بعض السكان في فضاءات معيّنة: المخيمات، ومستندًا إلى رؤى “أغامبن” يصرّح “مبيمبي” أنّ نموذج المخيم (اللاجئون، السجون، الأحياء الشعبيّة، الضواحي، أحياء الصفيح) أمست طريقة رائجة لحكم\إدارة السكان غير المرغوب فيهم. إذ يُحتجَز هؤلاء في “حالة دائمة من العيش في الألم” وفي فضاءات مؤقّتة وعسكريّة ليتمّ التحكّم بهم ومضايقتهم وربما قتلهم.
أمّا السمة الثالثة والـ “مفتاحيّة” “سياسة إدارة الموت” فتتمثّل في” إنتاج الموت على نطاق واسع” تبحث هذه الجزئيّة خصوصًا في فقرة عنوانها “علاقة بلا رغبة ” من الفصل الأوّل” الخروج من الديمقراطية ” ويمكن تفسير هذه السمة عبر سبع سمات أساسيّة -كما أراها- تدعم سرديّة “مبيمبي” للموضوع :
1 – إرهاب الدولة: تضطهد الدولة وتسجِن وتزيل مجموعات سكّانيّة معيّنة لتحييد الاحتجاجات السياسيّة والاجتماعيّة، وتُنفّذ هذه التكتيكات القمعيّة ليس فقط من قِبَل الأنظمة التوتاليتاريّة، بل أيضًا من قِبَل الدول الليبراليّة وشبه-الليبراليّة المعاصرة.
2 – الاستخدام المشترك للعنف: في كثير من الأحيان، لا تمتلك الدولة احتكار العنف، بل تشاركه عن قصد مع فاعلين خاصّين آخرين (ميليشيات، شبه-عسكريين)، ما يزيد من تداول الأسلحة واستخدامها في المجتمع. ويُقسَم المجتمع إذًا إلى”من يُحمَون (لأنهم مسلّحون) ومن لا يُحمَون”.
3 – رابطة البغضاء – link of enmity: بحسب مبيمبي، في مجتمع يُعرِّف فيه امتلاك\حيازة السلاح أو عدمه قيمة الإنسان الاجتماعيّة، تُدمَّر كلّ الروابط الاجتماعيّة. لتُرسّخ رابطة البغضاء إذًا ” فكرة أنّ السلطة يمكن اكتسابها وممارستها فقط بثمن حياة الآخر”.
4 – الحرب: “أصبح الإكراه بذاته سلعة سوقيّة” ” مبيمبي”
أضحت الحرب والإرهاب اليوم، وسائل إنتاج قائمة بذاتها، وبالتالي ينبغي أن تُنتج أسواقًا عسكريّة جديدة.
5 – نهب الموارد الطبيعيّة: لاستغلال موارد طبيعيّة ثمينة، يُزاح السكان ويُزالون (مثل السكّان الأصليّين في غابة الأمازون) بالتعاون الفاعل والمستتر بين الدولة، والقوّات المسلحة العامّة، والشركات الدوليّة، والمنظمات الإجراميّة.
6 – أنماط القتل المتنوّعة: التعرّض للموت متنوّع: التعذيب، التشويه، القتل الجماعي، المحو – elimination عالي-التكنولوجيا عبر ” ضربات الطائرات المسيّرة “، كلّها أجهزة نكرو- سياسيّة متعدّدة الأشكال.
7 – المبرّرات الأخلاقيّة المتنوّعة: تُبرَّر الفظائع – وفقاً لمبيمبي – لأسباب متعدّدة مثل القضاء على الفساد، وأنواع مختلفة من ” الطقوس العلاجيّة – therapeutic liturgy ” ، و الـ “رغبة في التضحية “، و ” التضحيّة المستندة على البعث الأخروي – messianic eschatologies”، وحتى “خطابات الحداثة النفعيّة والماديّة والاستهلاكيّة”.
تقتضي “سياسة إدارة الموت” إذًا ترابطًا متينًا بين الأجهزة السياسيّة والاقتصاديّة والعسكريّة، يُوجَّه نحو إزالة السكان البشريين. لكنّها، إلى جانب هذا الجانب، تُمارَس أيضًا عبر “جرعات صغيرة” من الموت تُهيكل الحياة اليوميّة للأفراد.
أقلّ إنسانيّة من إنسان
إلى جانب عمليات القتل الجماعي والإبادة، يجادل “مبيمبي” بأنّ “سياسة إدارة الموت” تقتضي مراقبة الأفراد ليس من أجل الانضباط، بل لاستخراج أقصى فائدة منهم، كما في حالة العبوديّة الجنسيّة.
وتأتي هذه الجرعات الصغيرة من الموت في حياة الأفراد اليوميّة أيضًا من “عنف اجتماعي واقتصادي ورمزي غير محدود” يدمر أجسادهم وقيمة وجودهم الاجتماعي.
إنّ الإذلال اليومي الذي ترتكبه القوّات الحكوميّة العامّة ضدّ مجموعات سكّانيّة، واستراتيجية “المذابح الصغيرة ” المفروضة يومًا بعد يوم، وغياب المنافع الاجتماعيّة الأساسيّة (مثل الصرف الصحي والسكن) تُحدث نوعًا من الوجود تتلخص قيمته في “ماهيّة طبيعة الموت بعد هذا الوجود”، وفي ظلّ هذه الظروف، تتكوّن “سياسة إدارة الموت” :
” في سلطة القدرة على تكريس حشد كامل من الناس يعيشون على حافة الحياة، أو حتى على طرفها الخارجي – أشخاص يعني العيش لهم الوقوف المستمرّ في وجه الموت … إنّ هذه الحياة حياة فائضة – superfluous بلا أهميّة، فثمنها زهيد إذاً، لدرجة أنّه لا يعادل شيئًا، لا سوقيًا ولا – أقلّ من ذلك- إنسانيًا … فلا أحد يشعر بالمسؤوليّة أو يطلب العدل، ولو بالقدر الأدنى، تجاه هذا الشكل من الحياة أو -بالأحرى- من الموت. تعمل سلطة إدارة الموت – Necropolitical عبر نوع من التناظر-القلب بين الحياة والموت، وكأنّ الحياة هي مجرد وسيط للموت”
في ظلّ “سياسة إدارة الموت” اليوميّة، تعيش كتل سكّانيّة في اوساط غير مستقرة وهشة بشدة، وبالتالي يمكن استغلالها وإزالتها “طبيعيًّا”. يُبرز “مبيمبي” العنصريّة بوصفها المعيار الرئيس الذي يتيح أداء “سياسة إدارة الموت” وتوسّعها في المجتمع.
فإلى جانب “عنصريّة هيدروليكيّة – hydraulic racism ” تُعرّف العنصريّة المؤسّساتيّة (الدولة، القانون، الإدارة)، يشدّ “مبيمبي” الانتباه إلى ما يُسمّى ” بالعنصريّة النانويّة – nanoracism “التي تُمارَس في العلاقات الاجتماعيّة اليوميّة، وتُصمَّم لتشويه، وإيذاء، وإذلال ” أولئك الذين لا يُعَدّون منّا “. وبالنظر إلى أشكال العنف السياسيّة والاجتماعيّة والرمزيّة المنتشرة في العالم اليوم، يُعدّ مفهوم مبيمبي “سياسة إدارة الموت” حقل معرفي إسترشاديّ وثيق الصلة بالفكر النقدي المعاصر.